وليد إخلاصي

المحتويات
- مقدمة
- سيرته الذاتية
- ولادته
- الانتقال إلى حمص وولادة أخته هند
- لقاؤه الأول مع ما يُسمَّى بالموت
- حماة: المحطة الثالثة
- مدرسة الحمدانية في حلب
- مظاهر الفقر والضنك في حياة العائلة
- دار الكتب الوطنية
- أول عمل قام به
- عمله الثاني
- خان الشربجي
- وأيضاً عنترة
- السرتفيكا
- العلم بعيداً عن المدرسة
- بدايات تجربته الدينية
- موقف الشيخ الأزهري من الفن
- ميوله الأولى وعلاقة المسرح بالسينما في رأيه
- قصة السيد صقّال والحوار بين الأديان
- التكية الإخلاصية ومفهوم التعصب
- موقفه من التجمعات السياسية والدينية
- النضج
- قصة طرده من المدرسة في صف البكالوريا
- الفشل في اجتياز امتحانه الأول
- النجاح
- مصر
- موجز سريع لحياته بعد إنهائه دراسته في كلية الزراعة
- نظرة في بدايات حياته الإبداعية
- وضعه العائلي
- أزمة قلبية
- الوظائف التي شغلها
- عالميته
- الجوائز التي نالها
- أعماله
- وليد إخلاصي والمسرح[2]
- المراجع
- هوامش
.
مقدمة
جبلاً ارتفع من عمق هذه الأرض، والجبل في تكونه وارتفاعه، وامتشاقه عنان السماء، يعرف جيداً، ويدرك تماماً رفاقه الجبال، فالجبل لا يتكون في الوديان، ولا في السهول، بل يتكون وسط الجبال، ومن هنا نعرف أنه جبل يسمو بقمته وسط الجبال. هكذا، كان وليد إخلاصي، الذي جمعه مقعد الدراسة ذات يوم مع صباح أبو قوس الذي أصبح اسمه صباح فخري، الأب الروحي للقدود الحلبية، وكذلك، في ثانوية التجهيز كان من المقربين له، والذي لا ينقطع عن التواصل معه، صديقه الذي تعرف إليه في القاعة الكبيرة المخصصة لأغراض متعددة كالرسم، وهو من أصبح فيما بعد الفنان التشكيلي لؤي كيالي، كما كان زكي الأرسوزي أحد أساتذته، وكذلك الشاعر سليمان العيسى، وفي الإنكليزية كان أستاذه فاتح المدرس، كما عاصر أستاذاً كبيراً في حلب حين كان طالباً في الثانوية، وهو صاحب موسوعة حلب، وأغاني القبة، إنه العلامة خير الدين الأسدي.
كان وليد إخلاصي كبيراً منذ أن كان صغيراً، وهذا الصغير الكبير، كان يعرف التحدّي بشراسة دفاعاً عن إبائه وكرامته، وما كان لهذا الصغير الكبير، إلا أن ينتظر يوماً يقول فيه للعالم: «أسمع ضربات قلبي على الورق، والعالَم حسناً أصغى، ومازال يصغي إلى نغماته العميقة التي تنزل كنهر هادر من أعالي الجبال!!».
سيرته الذاتية
ولادته

والده هو الشيخ الأزهري أحمد عون الله إخلاصي وقد عُيِّنَ مديراً لأوقاف إسكندرونة فأخذ أسرته المكونة من زوجة وولدين هما نزار الكبير وعدنان الصغير، وذهب بهم إلى إسكندرونة تاركاً حلب والزوجان مازالا في قمة الحيوية والشباب، وها هي الأم تحمل في بطنها ثمرة جديدة. وجاء الابن الثالث وهو المسمى «وليد» الذي أطل على الحياة ليلة السابع والعشرين من أيار للعام 1935.
الانتقال إلى حمص وولادة أخته هند
كان قرار انتقال الوالد إلى عمله الجديد قد ابتدأ مفعوله في يوم من العام 1937، فاتجهت بهم السيارة إلى مدينة حمص التي سيدير فيها والده أوقاف المدينة.
وما أن مرت سنوات أربع على قدوم وليد إلى الدنيا ليكون الابن الثالث في أولاد الأسرة، حتى كان التوقيت في أن يصبحوا أربعة أخوة، وهكذا كان احتفال الأسرة بقدوم المولود الجديد مع استثناء، فقد كان القادم بنتاً.
كما أن استضافة هذا الكائن ذهب بوقار الأب فكان يحملها بين ذراعيه منادياً «هند..هند» ويدور بها في أرجاء الصالون مكرراً ترحيبه بها وشاكراً الله على تلك النعمة وداعياً الجميع إلى التوجه بالامتنان إلى فضل الله على الجميع. وظل الشيخ في صلواته يتوجه إلى السماء بالامتنان لمنحها أسرته تلك الهدية الغالية.
لقاؤه الأول مع ما يُسمَّى بالموت
لقد ابتدأ الطفل (وليد) يسمع حكايات وإشارات عما يسمى الجنود الفرنسيين وقسوة احتلالهم للأرض السورية التي كان يعتقد أنها تدل على الإسكندرونه وحمص فإذا هي تدل على ما هو أكبر من المدن التي احتضنته.
كان هناك جار لهم في العمارة المجاورة وهو شاب جميل بقامته اللافتة للنظر وبسماحة وجهه، فهو إذا قابل واحداً من أطفال الحي داعبه بمودة ورحب به، وكان يطيل في زيارته لبيت عائلة وليد، فيعلم وليد أنه يتبادل مع والده محبة خاصة، كان اسمه مصطفى السباعي. وذات يوم، تدفق الناس نحو العائلة وهم يحملون جسداً تمزق صدره. والأكف ترفع جسد جارهم (ابن الحسامي)، وقد تدلت ذراعاه، ودخل التكبير والتهليل عمارة الشاب الذي قيل إن رصاص الدمدم قد أودى بحياته. ذلك المشهد كان أول معرفته بأمر اصطلح على تسميته بالموت. وصحح والده الكلمة بأنها الشهادة.
حماة: المحطة الثالثة
كان قدوم العائلة إلى حماة في يوم من الأسابيع الأولى من العام 1940. وكانت دراسته الابتدائية في أول سنة في حماة. وما أن انقضت سنة أو أكثر بقليل حتى أعلن الوالد عن قرار جديد سيعيدهم إلى حلب. وكان الوالد فرحاً لقرار العودة إلى المدينة التي جاؤوا منها. حيث كان قرار نقل وظيفة الوالد قد وصل في الصباح.
مدرسة الحمدانية في حلب
قُبِلَ وليد في مدرسة الحمدانية طالباً في الصف الثاني. وكان اليوم في المدرسة يبتدئ عادة بتحية العلم. وعلى إيقاع الطبل يرتفع العلم السوري على السارية فترتص الصفوف أمامها يتقدمها أستاذ الموسيقى أو المدير بنفسه، ويبدأ التلاميذ يرددون النشيد الوطني «حماة الديار عليكم سلام»، فكان طقس الصباح يشكل جانباً من المحبة للوطن الذي ما زال يقبع تحت سيطرة الاحتلال الفرنسي الذي لا يتوقف عن نشر الجنود في معظم الأحياء وكأنهم شركاء في امتلاك المدينة التي لم تتوقف عن إبداء استيائها في السر والعلن.

ويذكر وليد قائلاً: «وبالرغم من مرور مئات السنين على بناء المدرسة، فقد تشققت جدران فيه ونمت أعشاب بين حواف بلاط الحوش، وسقطت زخارف سقف أو باب، فالمدرسة حافظت على هيبة تغنى بها الأساتذة والزوار. كانت الحمدانية مكاناً يعيش في الوجدان فيسعى إليه التلاميذ كل يوم بمحبة تعادل التعلق بالبيت والأهل. كانت الحياة الجميلة تتوزع بين البيت والمدرسة فلا تحمل العودة إلى المنزل سوى الرغبة في انتظار الذهاب إلى المدرسة».
مظاهر الفقر والضنك في حياة العائلة
لم تتلق والدته أية فرصة في التعليم. لم تكن تقرأ أو تكتب ولكنها حفظت آيات قصاراً من القرآن الكريم تنفعها في أداء صلواتها المنتظمة. وقد شهدت أيام الضيق المادي قدرتها في تدبير أمور أولادها المدرسية. كانت تعد الحبر لاستخدامهم، فكانت تذيب بلوراته في الماء الساخن لحفظ الحبر في زجاجة يملؤون منها محابرهم المصنوعة من التنك، كما أنها كانت تحيل الورق المستخدم للتغليف (ورق الصر) إلى دفاتر تخيطها بالمسلة، فقد كان ثمن الدفاتر في المكتبات يشكل عبئاً ثقيلاً. كما أن الوالدة لم تنقطع عن ترميم الكتب الممزقة فقد كان المتداول عند معظم التلاميذ والطلاب هو التبادل بين السابقين واللاحقين في السنة الدراسية.
أثناء سنوات الحرب العالمية الثانية كان الاحتلال الفرنسي يسيطر على المحاصيل الزراعية كالقمح والشعير، ووضع نظام القسائم التي توزع على الناس المحصول وفق حصص شهرية من الطحين.
ولما كانت نسبة الشعير هي الغالبة في الطحين، كان الرغيف أكثر صلابة، وخصوصاً أن كل عائلة كانت تخبز الرغيف على نفقتها الخاصة، وهكذا اضطر الوالد بالاتفاق مع الوالدة إلى طحن البطاطا المسلوقة لتعدّل من قوام العجين، فساهمت في إظهار الرغيف بليونة أفضل.
كما أنهم أمضوا زمناً من حياتهم دون توفر مدفأة في البيت تردّ عنهم برد الشتاء، وكان المنقل هو الوسيلة الوحيدة لإرسال الدفء بجمراته التي تظل لامعة إلى فترة من الليل ليخمد بريقها بعد ذلك.
وفي اجتماع عائلي عقب العشاء، أعلن الوالد عن حصوله على مدفأة قديمة، وكانت المدافئ تعمل آنذاك بالحطب. وكان لدخول واحدة إلى البيت فعل السحر، فكانوا يمسحون عليها بأيديهم غير مصدقين.
وفي حلب ارتفعت وتيرة الأزمات الاقتصادية يشارك في تأجيجها الاحتلال والحرب. فكانت السجادتان اللتان استطاع الوالد شراءهما أثناء إقامته في إسكندرونة، والسماور المصنوع من الفضة والذي كانت نيرانه تحافظ على صلاحية الشاي للشرب، شيئين ثمينين شكلا - أي السماور والسجادتان العجميتان - إحدى الحلول التي لجأ إليها الوالد لمواجهة الضيق والعسر.
دار الكتب الوطنية
شُيِّدَت دار الكتب الوطنية منذ سنوات، وكان موقعها في ساحة باب الفرج يواجه برج الساعة التي أقيمت أيام الحكم العثماني، فتحولا إلى علامة للساحة التي اختفى منها باب الفرج المندثر مع معظم أبواب السور الذي دافع عن المدينة لقرون عديدة. وكانت إدارة الاستخبارات الفرنسية قد وضعت يدها على الدار الأشبه بقصر أمير، فقامت البلدية باستئجار مبنى قديم على حدود مقبرة العبارة لتكون بديلاً لدار الكتب الوطنية.
وكان وليد يتردد على المكتبة تلك بين حين وآخر فيقرأ كتب الأطفال فيها، ويبدو أن مكتبة والده الصغيرة هي التي حفزته على القراءة لإعجابه بها وبتاريخه الذي كشفت عنه أعداد من مجلة «الاعتصام» كان رئيساً لتحريرها قبل أن يولد وليد. وقد توقفت تلك المجلة عن الصدور بأمر من الحاكم الفرنسي في أوائل الثلاثينات. وبات حلم وليد المبكر في أن يتمثل حياة الوالد، وهكذا أصبحت القراءة واحدة من الهوايات كاللعب بالكلال (الدحل الزجاجية) والجري وراء كرة القدم ومشاهدة الأفلام السينمائية.
أول عمل قام به
لم يكن المصروف الشهري الذي يحصل عليه من والده يكفي لشراء كتاب أو تسديد أجر له، وكذلك الحصول على تذكرة لدخول دار السينما. فقرر أن يعمل، وجاءت العطلة الصيفية لتكون الفرصة الأولى في كسب المال.
وقد قبِلَ قريب لجدته يصنع السكاكر بعد التوصية أن يعمل عنده. وكان المعمل في حوش داره التي تشكل دكان البيع واحداً من مداخله. سمح له عمره بمشاركة مجموعة النسوة ليعمل معهن في لف قطع السكاكر بالورق الملون، فكانت أجرة الكيلوغرام الذي ينجزه تدفع له مباشرة. ولا ينكر أنه كان بين فترة وأخرى يمعن النظر لثوان في الصبايا اللواتي لم يعرن اهتماماً لصبي مثله أو يخشين من نظرة تصدر عنه فيتصرفن في الجلوس بحرية أمامه، فالصبي كما يرددن أحياناً هو «ابن ناس».
ولم تدم له أيام العمل اليدوي طويلاً، فقد اختاره سيد العمل (سعيد) كي يستلم الصندوق في الدكان، وليكون المسؤول الوحيد في معظم الأوقات عن البيع بمفرده وإجراء تسجيل الدخول بدقة. وسيروقه ذلك العمل فيشعر بالفخر وقد بلغه قول المعلم يشيد بأمانته وحرصه على التعامل الجيد مع الزبائن.
عمله الثاني
لم يكد يترك عمله الأول، حتى استيقظت عنده لذة العمل المأجور. وبدأ يفكر في طريقة يحصل فيها على المال، وهكذا وجد نفسه يغامر بالتوجه إلى مخزن كبير للأدوات المنزلية يعاين محتوياته التي تزيغ البصر. مكث فترة يتنقل من ركن إلى ركن يقلّب النظر في الصحون والكؤوس والطناجر ومئات المواد الأخرى، فما كان من رجل ملتحٍ شد وسطه شال عجمي إلا أن توجه إليه، ودلت هيبته وهو يسأل عن طلبه على أنه صاحب المخزن.
أعلن وليد فجأة ودون تفكير عن رغبته في بيع أدوات منزلية على البسطة التي كانت شائعة في الشارع المجاور لسور الجامع الكبير. تفحصه الرجل بنظراته وما لبث أن مال بقامته عليه وهو يسأل عن المبلغ الذي يمتلكه ثمناً للبضاعة، فما كان من وليد إلا أن صرح بقدرته على الدفع بعد البيع، فاتسعت عيناه دهشة وكأنه يقول «وهل الأمر بهذه البساطة؟»، إلا أنه هتف بشيء من الاستياء «وهل تعتقد أن الأمور في السوق تمشي هكذا»، لاذ وليد بالصمت لعلمه بأن طلبه لم يكن منطقياً فدار على نفسه طلباً للمغادرة، فما كان من الرجل إلا أن استوقفه ليسأل عن اسمه وابن من يكون.
فقال بصوت منكسر أنه ابن الشيخ عون الله إخلاصي، ثم أضاف باعتزاز إلى أنه الأصغر بين أبنائه، فتغيرت ملامح الرجل وهو يقول «إذن فأنت ابن رجل نحبه ونجلّه». وأشار إلى عامل عنده أن يأخذ بيده ليختار ما يشاء من بضاعة دون ثمن مسبق، وقال له «تستطيع أن تسدد الذمة لتعود وتأخذ من جديد ما تريد».
خان الشربجي
كان بيت العائلة في منتصف المسافة بين دار الكتب الوطنية وخان الشربجي القائم في منطقة باب أنطاكية. وقد حول الفرنسيون ذلك الخان إلى معتقل يُحتجز فيه المعارضون للاحتلال والمنادون بالاستقلال بدءاً بالسياسيين المعروفين وانتهاء برجال من الأحزاب أو من أهالي الأحياء القديمة.
وكانت التظاهرات تمر عادة من ذلك الشارع الطويل وهي تتجه إلى مبنى المحافظ المشيد أمام القلعة، فكان مرور التظاهرة من مسافة قريبة من الأمور التي اعتاد على مشاهدتها عبر النوافذ، فإذا ما ابتدأ إطلاق النار تتوارى العائلة في الداخل خوفاً من رصاصة طائشة. وبات من المألوف أن يتقدم التظاهرة عادة رجل شعبي يخب بشرواله كزعيم وهو يحمل العلم السوري ملوحاً به كما يفعل مربو الطيور على الأسطحة. وعرف أفراد العائلة من ابنهم نزار أن اسم ذلك الرجل هو أبو صطيف.
كان حلم هذا الرجل يتجسد في وضع حد لأسطورة السجن (خان الشربجي) كما كانت مخاوفه على الناس من رصاص الدمدم، وكان ذلك الرصاص هو الذي فجر صدر أبو صطيف. فسقط الرجل قتيلاً، وكانت له جنازة فاقت أعداد المشاركين فيها أكبر تظاهرة عرفت من قبل. ولم يتوقف ذكره بين أفراد العائلة، وتذكره الجميع في همهماته السحرية وفي طريقة شربه للشاي، وفي القيام بخدمة الذين جاؤوا معه وكأنه صاحب الدار.
وأيضاً عنترة
كان عنترة واحداً من الأشقياء الذين يدخلون المهابة لمن يقابله من الأولاد فيحسبون له ألف حساب فما يجرؤ أحد على مخالفة أمر له. وبالرغم من أن عمره لم يتجاوز الخمسة عشر عاماً فإنه ظهر لنا كرجل قوي يمكن له أن يرفع صبياً بين ذراعيه ويلوّح به في الهواء كدمية يتسلى بها.

وذات مرة، احتشدت مظاهرة كبرى في وسط المدينة، وعلى جسر النهر حوصرت مقدمة المظاهرة بين طرفيه، وقوبلت الحجارة المتساقطة على الجنود بالرصاص ينطلق من بنادقهم بهدف الإصابات المباشرة. مزقت رصاصات الدمدم صدور المتظاهرين، وكان أحدهم عنترة بنفسه وقد أصر على أن يكون في المقدمة.
السرتفيكا
كان حصول وليد على السرتفيكا بداية التحول في حياته. بين فراق الحمدانية والانتقال إلى ثانوية التجهيز الأولى التي تبدأ الدراسة فيها بالصف السادس، وهكذا شعر بالفرح والحنين في نفس الوقت، الحنين إلى الماضي، والفرح بأنه أصبح طالباً في مدرسة الكبار.
العلم بعيداً عن المدرسة
قرر الوالد أن تعلق ابنه بالقراءة يستوجب الاعتناء باللغة العربية. ولم يكن هناك من وسيلة إلا في قراءة القرآن الكريم وحفظ أكبر قدر من آيات السور يتلقنها على يد شيخ خبير يتقن التلاوة. وهكذا التحق صيفاً بمدرسة الحفاظ وهو ما زال في العاشرة من العمر.
وبات يقرأ على والده بعد ظهر أيام من الأسبوع صيفاً وشتاء. كان مجلد «نهج البلاغة» أمامه يقرأ في صفحاته بمتعة على الرغم من صعوبته فيوقفه الوالد عند مقاطع ليشرح ويفسر فيزداد وليد تعلقاً بالكتاب، وإذا يتابع القراءة بصوت مسموع كان يثني عليه أو يشعل سيجارته فيرسل دخانه الذي يفسره وليد على أنه راض عن التزامه. كان المؤلف للإمام عليّ وشرح الشيخ محمد عبده عليه، وقد لازمته متعه التعرف عليه لسنين طويلة، فحمل تقديراً آخر لوالده الذي سمح له بقراءة ذلك الكتاب.
بدايات تجربته الدينية
1) الذكر والإنشاد:
مرت عليه أيام كان في بعض منها يتردد على حلقات الأذكار. صبياً كان فاستهوته زاوية في حي العقبة كانت تابعة لواحد من أقارب أمه. يجتمع فيها رجال بقيادة شيخ تتمايل لحيته مع الإيقاعات المتسارعة لذكر الله. وسمح له صوته الرفيع بالتفرد مرة بالإنشاد فلقي استحساناً، إلا أنه مع تكرار سقوط عدد من المشتركين بالذكر أرضاً وانتشار الزبد على الأفواه، اتخذ وليد موقفاً من التردد على الزاوية إذ لم يكن عنده تفسير لحالة من أسكره الذكر.
2) الدعاء:
في حين أن والده كان أكثر توازناً واعتدالاً في طقوسه الدينية، فمثلاً كان يحدث في ليلة النصف من شعبان، أن تجتمع الأسرة حول الوالد وهي تردد الدعاء بورع:
«اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب.
شقياً أم محروماً أو مطروداً أو مقصراً علي في الرزق.
فامح اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي.
وإقتار رزقي».
كما اعتاد أصدقاء والده من الشيوخ زيارة العائلة في لقاء مسائي، وحدث مرة أن كان وليد يقدم الشاي للضيوف، فنظر إليه واحد من الشيوخ الأقرب إلى والده وهو يتناول الكأس وقال: «حدثني يا بني عن الدعاء الذي تختتم به صلاتك عادة»، فوجد نفسه يجيبه دون تفكير: «عادة يا عمي، أدعو الله أن يمنحني نعمة الرضا». توقف الشيخ محدقاً به، وما لبث أن وضع كأس الشاي على مسند المقعد وقال بتساؤل المحقق: «من أين أتيت بهذا الكلام الكبير؟»، ثم بإلحاح «من علّمك هذا؟»، وإلى والده يسأله: «لابد أنك يا شيخي علمته»، فكان الجواب «لا لم أفعل وهذه أول مرة أسمع فيها هذا الدعاء». وقال الشيخ الأزهري للآخرين: «ألا تجدون هذا الدعاء أكبر من قدرة صبي». وعاود السؤال إليه: «وهل تقول لنا ما معرفتك بالرضا؟»، فكان رده كسابقه بعفوية: «أن ترضى بما قسمه الله لك»، وأضاف بعد تفكير: «الرضا هو السعادة».
3) السماع:
وفي رمضان، كانت مديرية الأوقاف تستضيف في شهر الصيام قرَّاء معروفين من مصر لإحياء ليالي القرآن في الجامع الكبير الذي يمتلئ عادة بآلاف المصغين بخشوع، فشهرة أولئك القرّاء الكبار تعادل عند الناس تقديرهم لمغنين كأم كلثوم وغيرها.
وكان الشيخ مصطفى إسماعيل واحداً من أشهر الذين استجابوا للدعوة، ومن الذين لبّوا دعوت إلى الإفطار في بيت وليد، فكانت أمسية رمضانية سجلت في تاريخ الأسرة علامة. وبات وليد بعد تلك الزيارة يتابع الإذاعة المصرية لتكون له المتعة الروحية في تلاوات عدد من القرّاء، كما قدمت له الموسيقى الكلاسيكية مثلها وهو يتابع برنامجها في الإذاعة السورية. وكما كان يدرك الأهمية البالغة لمقرئين هما الشيخ محمد رفعت والشيخ مصطفى إسماعيل أوصلا جوهر المعنى القرآني في تلاواتهما، عرف وليد القيمة الروحية لموسيقى موزار وبتهوفن وفيفالدي وغيرهم. وأدى ذلك إلى التقاط العلاقة الوثيقة بين القرّاء العظام والموسيقيين الذين أجمع البشر على دورهم في الارتقاء بهم إلى شيء وجد وليد له اسماً وهو «نشوة الفرح». ويوم قرأ وليد عن الشيخ محمد رفعت أن هوايته كانت في الاستماع إلى الموسيقى الكلاسيكية بواسطة آلة التسجيل الأسطوانية والتي لم يكن يمتلكها في الوطن العربي إلا قلة قليلة، أدرك وليد الكثير عن اللقاء الخفي بين الطرح المبدع للعقيدة الدينية والفن.
4) التأمل:
من الجدير ذكره حادثة جرت له في مرحلة دراسته الثانوية، وهي حادثة في منتهى الأهمية، فهو يذكر أثناء قراءته لكتاب «حي بن يقظان» لمؤلفه ابن طفيل. تساءل آنذاك عن معنى اكتشاف الفتى (حي)، الإنسان الوحيد في جزيرة منعزلة عن العالم، لمعنى الخالِق نتيجة التأمل الطويل، وبعد أن فقد الغزالة التي كانت أماً له ورعته منذ البداية. كانت معاينته للفضاء من حوله كوة دخل منها النور الذي أضاء وجود الله دون أن يكون له سند يهديه إلى الحقيقة.
ويذكر في حديث له مع والده، وهو يسأل عن حي بن يقظان الذي عثر على كتابه في مكتبة البيت، أنه علَّق على قدرة الفتى الوحيد في الاهتداء إلى حقيقة الله، ولم يكن في الأصل نبياً. وجاء في رده تأكيد على المقولة الإسلامية التي انطلقت من أن الإسلام هو دين الفطرة، وهي جوهر الأديان. وقال له أن الوصول إلى هذا الجوهر يتعلق بفهمنا لما هي عليه الفطرة، بمعنى أن الإنسان أصلاً يهتدي إلى إيمانه بالخالِق دون مساندة من أحد بل إن الفطرة هي نقطة البداية.
موقف الشيخ الأزهري من الفن
أعلن الأخ الأوسط عدنان عن رغبته في شراء جيتار، جمع ثمنه من أعمال صيفية مأجورة في مستودعات الميرة، وكان ذلك فرصة لإظهار اندفاع الوالد إلى إبداء رأيه الذي يؤيد الفن، وكان العزف على آلة من الأعمال الفنية التي تستحق أن يكون لها معلم. ويعتقد الوالد أن فرصة العزف على آلة العود تسمح بالعثور على مدرب لها بما قد يشكل صعوبة مع آلة الجيتار غير الشائعة.
لم يتأخر موعد حضور معلم العود الشيخ بكري الكردي وهو الذي أصبح أستاذ أخيه، وكان يتابع دروسه اليومية على ضوء كتاب «الصباغ» الذي دونت فيه نوتات الموشحات والسماعيات والقدود. كان الشيخ بكري يعمل في الجامع الكبير مؤذناً أو خادماً، إلا أنه عرف بين أهل حلب على أنه موسيقي وله مؤلفات من الأغاني المتداولة والأناشيد الدينية يتداولها رجال يحيون الأعراس والموالد.
ميوله الأولى وعلاقة المسرح بالسينما في رأيه
يذكر وليد إخلاصي في سيرته الذاتية: «لم يقتصر تعلقي بالمسرح على حفلات المدرسة، بل كنا أحياناً مع رفاق وهواة نقدم مسرحية في دار عربية، فالمتفرجون يكونون عادة من أهل الحي وبعض المعارف، وأما الجيران فيطلون من أسطحتهم على الإيوان الذي يكون عادة خشبة المسرح». ويضيف قائلاً: «وكما هو حالي مع المسرح، فإن ميلاً خفياً لأن أكون حكواتياً يمكن الاعتراف به. وكنت ألجأ أحياناً إلى رواية حادثة للأصدقاء من حولي مملحّة بالخيال والإضافات، فسقوط أسنان صناعية لمعلم أو قريب يصبح سيرة مملحّة مبهَّرَة ليصبح سقوط الأسنان دليلاً على عقاب إلهي لذاك الذي يظلم بتصرفاته. ويبدو أن افتتاني بخيال الظل وأنا أتابع فصوله في دكان من حي قديم، وتعلقي بأبطاله (كركوز وعيواظ وبكري مصطفى) وهم يتحركون وينطقون من خلف القماش الأبيض، قد جعلني أكن تقديراً للرجل الذي يحرك الجلود والذي لم أره أبداً، وهو يؤدي أدوار الشخصيات فينطق الواحد منها وفقاً لطباعه، فكأن التنوع الذي يقوم به ذلك الرجل غير المرئي هو الذي وضع أساس المحبة للعبة المسرح التي أظنها أظهرت للعالم ما أصبح اسمه السينما».
قصة السيد صقّال والحوار بين الأديان
كان لوالده صديق قريب إلى نفسه بالرغم من اللقاءات القليلة بينهما في مقهى المنشية التي استمرت كحديقة بالرغم من محاصرة العمارات لها فكانت تنمو مع السنين في قلب المدينة، لتبقى من الأماكن القليلة التي يلجأ إليها الرجال لتبادل الأحاديث تحت ظلال الأشجار الضاربة جذورها في الأرض منذ عقود. وكان الصديقان مع آخرين يجتمعون في حلقة من الود وتبادل الأخبار والأفكار، بينما حلقات تجمع أخرى يتنافس أفرادها في لعب الطاولة أو الورق. وكان يسمح لوليد أحياناً بمرافقة والده إلى المنشية فيستمع إلى تحليلات حول أحداث العالم أو إلى شعر قديم يردده واحد من أهل الحلقة مؤكداً في نهايته على أن شعر هذا اليوم ما عاد كما كان في الماضي، وكان ذاك الصديق إذا ما كان حاضراً يعلق بقوله أنهم يجب ألا يغالوا كثيراً في إظهار الكمال في الماضي فتطوُّر الزمن يمنح أهله قدرة على التفوق أيضاً.
كان السيد صقال مسيحياً من عائلة قديمة في حلب، فلم يعرفوا عنه سوى أنه غير متزوج بالرغم من تجاوزه الخمسين، وإن لم يذكر لهم الوالد عن عمله شيئاً. وغطت محبة الوالد له على تفاصيل عنه بعكس أصدقاء آخرين علمت الأسرة عنهم الكثير. وقد أخذت تلك المحبة شكل الدموع في عيني والده وهو يأتي متأخراً على غير عادته اليومية في العودة من عمله الوظيفي. كان اشتراكه في تشييع صديقه الصقال هو سبب التأخير. وفي ذلك اليوم رأى وليد والده يبكي بحرقة وهو يذكر مصابه بفقد صديق له. وكان وليد لا يتخيّل أن رجلاً مثله يبكي. حزيناً بصمت ظل والده لفترة بعد رحيل صديقه وكان أيام العزاء يقف في الكنيسة مستقبلاً وفود المعزين على أنه أقرب الناس إلى الفقيد.
وقد تخيَّر وليد، بعد أشهر، مناسبة يسأل فيها والده عن أمر ظل يحيِّره لأيام. كان الوالد يقرأ في كتاب وضعه جانباً ليستمع إلى وليد يقول: «أعلم أن صديقك الراحل كان قريباً منك، وكلنا أدركنا أنه كان بمثابة أخ لك. صحيح أنه مسيحي، إلا أنني سمعت أقوالاً عنه لا أعلم صحتها». وقال الوالد: «وما الذي سمعته عنه؟». تابع وليد: «ولا أعلم إن كانت ظالِمَة أو ملفقة». ومع استجماع شجاعته قال: «يقولون إن السيد صقال لا يؤمن بالله». فوجد والده يجلِسه بقربه، ويقول: «اعترف لي بنفسه مرة، ولم أسمع منه بعد ذلك، أنه لا يؤمن بالله». فكان صمت لا يجرؤ وليد على اقتحامه، إلا أنه بعد قليل هتف: «وهذا ما يحيرني في لقاء مؤمن بملحد على الصداقة». فجعل الوالد يتحدث بحنان وكأن صديقه مازال قائماً: «كان واحداً من أشرف الرجال الذين عرفتهم في حياتي. أميناً على حقوق الناس. صادقاً في علاقاته ووعوده، ويحمل الاحترام للناس ولا يفعل شيئاً يضر بأحد بل يسعى إلى المنفعة لغيره». وقال الوالد وهو يستوي في جلسته على الأريكة: «إسمع يا بني، الإيمان أمر يخص علاقة الإنسان بخالقه، ولسنا نحن الذين نملك الحق لنحكم على أحد، الله هو الذي يفعل. الله خلقنا، الله يحكم علينا». واقترب من وليد متابعاً: «أريد أن تعرف أن الإنسان المؤمن ليس بمنزلة يصنِّفُ فيها البشر على مقاييس رؤيته للأمور. خلقنا الله ولسنا هنا في هذه الرقعة الصغيرة من الكون الوحيدين من خلقه. ألواناً مختلفة خلقنا، والنعمة هي التي ينالها أحدنا في هداية الله، فهو يهدي من يشاء، وأعلم يقيناً أن المرحوم قد هداه الله بنقله من عالم عادي إلى ملكوت الخير الذي كان يسبِّح».
التكية الإخلاصية ومفهوم التعصب
اصطحب الوالد وليداً في رحلة لم يكشف عنها. ومن الجانب الشرقي للقلعة انحدرا من أول حي باب الأحمر باتجاه باب الحديد الذي مازال باقياً من بوابات السور القديم. توقفا قبل خطوات من سوق النجارين. وقال الوالد وهو يشير إلى باب مغلَق: «انظر إلى ما هو مكتوب»، فتلاقَت عينا وليد بنقش حجري بارز يبرز كلمتين تدلان على اسم الدار وكان «التكية الإخلاصية». وهنا قال الوالد: «إن جدنا منذ أربعة قرون كان يعيش في هذه التكية متصوفاً. وأما الأطباء الذين حدثتك عنهم فهم من أحفاده». وكأنما هدفت تلك الرحلة القصيرة إلى دعم قوله في العلاقة ما بين دراسة الطب والدفاع عن الإسلام. آنذاك قال لوليد وهم يهمّان بالعودة: «يمكن لك أن تكون في المستقبل صلة الوصل بين العلم الذي يمثله الطب وبين الإيمان الذي يمثله الإسلام»، وأضاف: «لا يمكن لمستقبلنا أن يكون قوياً ومؤثراً في العالم إلا في بناء جسر بين العلم والدين».
وفي البيت أخرج الوالد من مكتبته كراساً يحمل عنوان «التعصب» للشيخ محمد عبده، وفيما كان وليد يقلِّب صفحاته كان يقول إن الشيخ لم يتوقف يوماً عن الدعوة إلى العلوم الحديثة كي تكون مع الإسلام الطريق الذي نسلكه، وفي دعوته إلى نبذ التعصب بل محاربته كان يؤكد على أهمية العلم للإنسان المؤمن. وقال إن التخلص من التعصب هو أول الدرجات المؤدية إلى الحداثة، وإن مقاومة التعصب ستظل دوماً ذلك الرمز الذي يدل على أن المرء كائن حديث.
وكان وليد قد نال شيئاً من معرفة الحداثة عبر القراءة، إلا أن الوالد قدّم له معرفة أوسع في شرحه لمفهوم التعصب ليس عند أتباع دين ما، بل كذلك في الأفكار والأحزاب، فكأنه في ربط محاربة التعصب بالحداثة يدل على فكرة ستصبح واحدة من الثوابت التي تغرس أقدامها في أرض وليد، وقد كان لهذا فعله في إقبال وليد على كتب التاريخ وعلم الاجتماع والنفس والفلسفة، فكان يعمِّق من يقينه بأن التنوع في ألوان المعرفة هو البناء السليم للتفكير. كما أن ملاحقة سِيَر الشخصيات الإنسانية في التاريخ تدعم تكوين مدرسة الانفتاح، فالمرء في قراءته تلك السِيَر يكتشف الأثر العميق الذي أحدثه أصحابها في حياة البشر. كونفوشيوس وسقراط، عمر بن الخطاب، والعز عبد السلام وابن رشد، غاندي وجان جاك روسو وتولستوي وبوذا، موزارت وبيتهوفن ودافنشي. الأنبياء والمصلحون والمجتهدون. شعراء وروائيون ومسرحيون، مناضلون وزعماء دول وحركات ثورية. قائمة من الأسماء التي تفتن المرء بأعمالها المبدعة وشجاعتها، والتي ستتحول إلى خميرة تنضج المشاعر في أرجاء هذا العالم، ويصبحون كالتضاريس في الأرض المنبسطة يتطلع إليها الزمن بإعجاب وتقدير كنتوءات استثنائية في زمن عادي.
موقفه من التجمعات السياسية والدينية
كان وليد ما يزال في الثانوية عندما تلقّى دعوة دينية فظهر أنها دعوة سياسية في قالب ديني ينحو منحى رجعياً، وبالتالي ما كان منه إلا أن غادر المكان، ثم تلقى دعوة أخرى للمشاركة في اجتماع للحزب الشيوعي وكلتا المشاركتين أحبطته إلى أقصى درجات الإحباط عندما أراد الحوار، والحوار بالنسبة له كان سؤالاً أو تساؤلاً، فكان المشرِف على الجلسات أو المحاضِر يرفض أية إمكانية للسؤال أو الحوار ويدعوه للاستماع فقط مما جعل وليد يتمرد آنذاك، ووليد يذكر في سيرته حول ذلك: «تنامت عندي في تلك الأمسية الشاردة جملة من المشاعر وهي تنوس بين حلقة السقيفة (الدينية) والاجتماع الشيوعي، فكان القرار الذي اتخذته في نهاية المطاف قسماً أمام نفسي بألاّ ألتحق يوماً بأي تجمع سياسي أو ديني، فلا أكون ملتزماً به بل أظل مراقباً له. وكأنني وصلت إلى حقيقة أن جميع الأحزاب لها ما يبرر وجودها، وأما عن وجودي فليس له من طريق إلا ما أؤمن به من حقيقة قد تكون هنا أو هناك، فكأنما الحرية هي التي تلزم الإنسان بمجتمعه ووطنه، وأن الحر هو من يحافظ على قدرة التساؤل المستمر».
النضج
وعن ذلك يقول وليد: «في البيت، ومع خلوتي بدأت أتلمس آثار الأيام السابقة في دفعي إلى شيء من النضج المبكر، وأفكر بأن الوقت حان لأتعامل مع نفسي والآخرين بكثير من التوازن اللائق بشاب صقلته تجارب مبكرة، إلا أنني لا أستبعد عن تحقيق رغبة في التوجه إلى من استهان بفعل التساؤل الذي كنت أعتقد أنه السبيل إلى اكتساب المعرفة فأقول له من أعطاك الحق لتقرر ما هو حق».
قصة طرده من المدرسة في صف البكالوريا
يروي وليد في سيرته الذاتية هذه الحادثة: «كان أستاذنا لمادة الديانة قد جاء من دمشق، واعتدنا عليه منذ الأسابيع الأولى وهو يمزج المقرر بأحاديث جانبية شدت الطلاب إليه، فيتحول الدرس إلى متعة لنا وبخاصة إذا ما سمح لنا بالاستفسار عن موضوع أو إبداء الملاحظات. وكان الأستاذ بيطار طويل القامة تذكرنا لحيته السوداء المشذبة مع الطربوش الأحمر الذي لا يرى مع غيره بصورة لزعيم جماعة الأخوان المسلمين بمصر (حسن البنا)، وبالرغم من تعليقاتنا المتفرقة حول ذلك التشابه فإن أحداً من الطلاب لم يُشِر إلى ذلك في حضور الأستاذ. واستفاض الأستاذ ذات مرة في الحديث عن الموت. وذهب في تصوير قبض الروح وهو من اختصاص الملاك عزرائيل الذي يحمل بيده حبلاً، فكأن الموت يحدث بشكل أشبه بعملية الشنق المعروفة. ويوم يحين وعد الموت يلتف الحبل حول العنق لتنتقل الروح إلى بارئها في السماء». وهنا طُرح سؤال وليد، ودار حوار بين الأستاذ ووليد الذي أردف يقول: «ألا تعتقد يا أستاذي بأن مثل هذه الصورة البدائية للموت تعود إلى تفكير أسطوري أظنه انبثق عن المعتقدات اليهودية»، ويذكر وليد في سيرته ما يلي: «آنذاك هتف الأستاذ بيطار ساخراً: "وما هو البديل عندك أيها الشاب الفهيم، هيا حدثنا عن البديل". وكنت للحظات لا أملك أي جواب على سخريته، إلا أنني أُلهِمت فجأة بحل أقدمه، فقلت: "الجميع يعرف الكثير عن الهاتف، فنحن إذا أردنا الاتصال بأحد طلبنا من السنترال المركزي الرقم المطلوب، وهناك يقوم العامل في المقسم بوضع الفيشة في ثقب الرقم ليتم الاتصال بين الطرفين، وإذا ما انتهت المكالَمَة يعود العامل إلى سحب الفيشة. وهكذا هي الولادة والموت، وصل للروح بالجسد أولاً ومن ثم قطع الاتصال بين الاثنين فيكون الموت". انفجر الطلاب بالضحك، بينما الأستاذ واقف يتأملني بصبر أنهاه بهتاف ساخر: "وهكذا قام طالبنا العبقري بتصوير الله وكأنه مدير الهاتف"، ثم صاح غاضباً: "ألا تخجل من هذا التشبيه أيها الكافر، الويل لك"، وامتدت ذراعه وقد اقترب مني كي تسقط كفه على وجهي، فلم يكن أمامي سوى الإمساك بالذراع بقوة شاب أرد العدوان عني. فإذا به يصرخ بذعر: "وتريد أن تضرب أستاذك يا كافر"، وينفلت خارجاً من الصف وهو يردد: "لا يكفيه التجرؤ على الدين فيضرب أستاذه، الويل لك يا كافر».
إذن، بعد هذه الحادثة التي أوشكت أن تطرد وليداً من التجهيز الأولى وكافة المدارس السورية، انتهى الأمر إلى طرد الطالب وليد حتى نهاية العام الدراسي الحالي. وصلت الأحداث إلى مسمع الوالد فما كان من هذا الأخير إلا أن اجتمع بصديقه مدير الثانوية الذي استدعى بدوره أستاذ الديانة ليخرج الاجتماع الثلاثي عن قرار جديد. وأعلمه الوالد أن الأستاذ بيطار سيكون بانتظار وليد لتقديم الاعتذار الذي سيعقبه إلغاء طرده فيعود إلى الانتظام في دراسته كما الحال من قبل، فيكون ختام القضية سعيداً.
ويذكر وليد في سيرته الذاتية ما جرى على النحو التالي: «وجاءت لحظة الاعتذار في الموعد المتفق عليه. توجهت إلى المدرسة فإذا بمشهد غير مألوف لي، الممر الطويل إلى المبنى الكبير يحتشد على طرفيه أعداد من الطلاب، فأسمع من طرف أقوالاًَ تندد بالكفر وتنذرني بعقاب أليم، ومن الطرف الآخر يأتيني تحذير من أن أخضع للقوى الرجعية، فكنت أتقدم تتجاذبني المواقف المتضاربة دون أن تثنيني عن الالتزام بوعدي إلى الوالد. وظهر لي الأستاذ بيطار قادماً من الداخل. توسط مجموعة من الطلاب التفّت من حوله على الدرجات الثلاث وقد انتصبت قامته واقفاً على أعلاها. كنت قد عرفت عن جموع الطلاب على طرفي الممر، منهم من كان من جماعة الإخوان المسلمين وحزب الشعب والحزب الوطني، وفي المقابل كان طلاب من الشيوعيين والقوميين السوريين وحزب البعث الذي أُشهِرَ حديثاً في المدينة. وإذا ما وصلت إلى المدخل مقترباً من الأستاذ بيطار، مددت ذراعي لأصافحه وأنا أقول: "أعتذر عما فعلته"، فإذا هو يمتنع عن مد ذراعه ويهتف بصوت مرتفع: "أريد منك أن تُسمِعَ جميع من في المدرسة اعتذارك وندمك على ما فعلت"، فوجدت نفسي أتابع التزامي وأرفع صوتي: "أقدم اعتذاري للأستاذ بيطار"، فما كان منه إلا أن هتف عالياً: "وأنا أرفض اعتذاراً من كافر"، واستدار عائداً إلى الداخل، وهنا لم أملك نفسي من الصراخ غاضباً: "وأنا أسحب اعتذاري. أسحب اعتذاري. أسحب اعتذاري". وسيحدث ما لم تشهد المدرسة مثله، اشتبك طرفا الممر، فكانت العصي والجنازير تلوح في الهواء، والتهديدات المتبادلة تتصاعد في الجو. ولم يكن لي من ملجأ أبتعد فيه عن العنف سوى اللجوء إلى داخل المبنى. وحضرَت الشرطة في وقت قياسي، اقتحمت المدرسة وفرقت المتعاركين، فكان يوم لا أنساه». وهذا كان يومه الأخير في الثانوية حتى آخر العام الدراسي.
الفشل في اجتياز امتحانه الأول
يقول وليد حول هذا: «ما من تعليق على فشلي في الامتحان. وإن كانت عيون الأهل تحاول أن تخفي شيئاً من الأسى. لم يكن هناك لوم من أحد أو إشارة إلى تقصير بل كانت كلمات والدي لا تحمل سوى نوع من العزاء: "الفشل في النجاح هذه السنة سيعقبه نجاح غداً، تلك هي لعبة الحياة يا ولدي، فلا تيأس". كان لم يبق مع والديَّ سوى أنا وشقيقتي، بعد أن غادر نزار إلى فرنسا وعدنان إلى مصر للدراسة، وكنت قد اعتزمت أن أتقدم إلى الامتحانات كطالب حر وأساعد والدي بعمل أحصل عليه، فالأعباء باتت ثقيلة ولابد من مساندة له. وحمل والدي البشارة بعد أن عثر لي على عمل لن يتعارض مع دراستي. أصبحت جابياً أجمع إيجارات من عدد من الأملاك المنتشرة في المدينة لصالح مديرية الأوقاف، فأحصل على نسبة مئوية كأجر لي على العمل الذي أقوم به في أول كل شهور ثلاثة. عشرات المنازل والدكاكين ودار للسينما واحدة، كانت تشكل القائمة فقمت بوضع برنامج للزيارات سمح بتنظيم وقت الدراسة. وهكذا شكلت الجباية علامة في سلسلة أعمالي بدءاً من مصنع الحلوى إلى تجارة سوق الجمعة وسوق بالستان والدروس الخصوصية الخائبة. وانتهت علاقتي بالجباية قبل شهر من موعد الامتحان، فتساوى عندي الليل بالنهار، فالنوم قليل والطعام يرافق الكتاب، ولم يعد هناك وقت لقراءة خارج المنهاج أو لمشاهدة فيلم مهما كان شأنه. وتحول سطح العمارة إلى مقر دائم للدراسة، فكان يتحول إلى مساحة أهرول فيها إبعاداً للنعاس وتنشيطاً للدورة الدموية بعد طول جلوس. وإذا ما أطلُّ على الشارع من تحتي في الليل المتأخر، تؤكد لي حركة السيارات والمشاة أن الحياة مازالت قائمة وأن الفائز في سباقها لن يتحقق له النصر إلا بمزيد من الإصرار وتحمل المعاناة. ومنذ اليوم الأول للامتحانات بدأت أشعر أن تجاوز المرحلة الصعبة يقربني حتماً من تحقيق أحلام المستقبل».
النجاح
يقول وليد في سيرته الذاتية: «الراديو كان الوسيلة الوحيدة لمعرفة نتائج امتحانات شهادة البكالوريا، وما أن جاء المذيع على ذكر اسمي حتى قفزت في الهواء كلاعب في السيرك تحميه من السقوط شبكة الأمان، فكان احتضان والديَّ لي هو الأمان والسعادة التي غمرتنا في نهاية القلق الذي تسبب به الانتظار. وتجدد الفرح عندما عدت بعد يوم حاملاً العلامات التي حصلت عليها، والتي أهَّلتني، لدخول كلية الطب في جامعة دمشق. إلا أن التزامي بوالدي دفع بي إلى دمشق التي قصدتها لأسجل في السنة التمهيدية المؤهلة لدخول كلية الطب. وكانت المصادفة هي التي جمعتني لحظة وصولي بزميل الدراسة الذي سبقني في دخول الجامعة. وقد دفعه التباهي بدراسة الطب إلى اصطحابي مباشرة إلى الكلية ليقدمني إلى مبناها فكانت المشرحة في طريقنا فأدخلني إليها، وكأنها كافية ليكون الإنسان طبيباً. رائحة الكلوروفورم شكلت مع جثة عارية ذلك المشهد الذي سيغير الخطة التي رُسِمَت لي. تراجعت، لا يتملكني سوى القرار الذي اتخذته دون تفكير، فدراسة الطب لن تكون هي المستقبل بأي حال. وكان علي أن أنتسب إلى الجامعة في أي حال لأضع والدي أمام حقيقة الواقع، فكان التسجيل في كلية الآداب هو ما عزمت عليه. وكانت الدراسة في هذه الكلية لا تستوجب التزاماً بالدوام، وبهذا أستطيع أن أعمل لأساعد والدي. وبات الأمر واقعاً، وأصبحت أملك القرار لوحدي في رسم مستقبلي. وفوجئت بوالدي وهو يصغي إلى تفاصيل ما حدث في دمشق يعلّق بحزن خفي: "هو مستقبلك أنت يا بني، وأنت مؤهل لاتخاذ قرارك بنفسك". إلا أن أخي عدنان عبر اتصال هاتفي من الاسكندرية كرر دعوته للانتساب إلى الجامعة فيها، وأغراني بوصف الحياة الجامعية وكأنها حلم لأمثالي، وطلب مني أن أتقدم بأوراقي إلى مكتب البعثات المصرية في دمشق قبل ضياع الفرصة». وهكذا ذهب وليد إلى مكتب البعثات في دمشق ليقابل المسؤول هناك الذي رحب به وقال له أن علاماته تؤهله لدراسة الطب هناك، ولكن وليد ارتأى له أن يُسجِّل في كلية الزراعة في جامعة الإسكندرية، فلا يحقق النجاح فيها فيحق له بذلك الانتقال في السنة القادمة إلى كلية الآداب. وهكذا كان، فقد انتهى الأمر بوليد أن سجل في كلية الزراعة في جامعة الإسكندرية.

مصر
يقول وليد في سيرته الذاتية: «كانت أيام إعلامي بالالتحاق بكلية الزراعة كمستودع تتجمع فيه أحلام وخيالات حول مصر التي درس فيها والدي منذ زمن، وهي البلد الذي يعيش فيه طه حسين والعقاد ونجيب محفوظ. مصر وطن أم كلثوم وليلى مراد ونجيب الريحاني وبيرم التونسي. بلد السينما والمسرح والموالد الشعبية. ومصر كانت بالنسبة لنا وطن الثورة التي أطاحت بفساد النظام الملكي وصدرت حرارتها إلى أرجاء الوطن العربي. وكانت صورة مصر لشاب مثلي أفضل من فرنسا التي كانت الدراسة فيها تمثل حلماً لأجيال، فالأفلام المصرية والمجلات التي قدمت لنا عالم مصر الجميل ببساطة أهله وتدفق مياه نيله وشموخ أهرامه، فبدا ذلك العالم أمنية في زيارة، فكيف بسنوات دراسة تعيشها. وابتدأت الطائرة رحلتها مع شمس الخريف في حلب، لتحط في مطار الإسكندرية الغارقة أرضه بمياه الأمطار. وكان المساء الذي تلمع الأضواء فيه يخفف من وطأة الاستقبال الذي لم يكن متوقعاً. وحملني التاكسي إلى عنوان أخي عبر شوارع مازالت تستقبل الأمطار، فكان وصولي إليه يترافق مع لحظة توقف السماء عن غضبها. وأنساني استقبال أخي كل ما واجهته من انغلاق المدينة.
في اليوم التالي، كانت الإسكندرية مشرقة بشمسها ودفئها وكأنها لم تشهد في ليلتها السابقة إجهاض الغيوم. وقادني أخي إلى مبنى كلية الزراعة ليضع مدخلها بين يدي قائلاً: "هنا ستمضي أيام دراستك"، وانفلت عائداً إلى كليته. واعتبرت أن السماء الصافية وهي ترسل بأشعة الشمس الذهبية هي مراسم الاستقبال الرسمية للوافد من حلب».
موجز سريع لحياته بعد إنهائه دراسته في كلية الزراعة
أنهى دراسته الجامعية بكلية الزراعة في جامعة الإسكندرية بمصر، وحصل على البكالوريوس عام 1958، ودبلوم الدراسات العليا عام 1960. ثم عمل في مؤسسة حلج وتسويق الأقطان بحلب حتى سنة 1999. وكان محاضراً في كلية الزراعة بجامعة حلب (1960 – 1971)، اُنتُخِبَ نقيباً للمهندسين الزراعيين ثم عضواً في مجلس الشعب (1999 – 2002). كما اُنتُخِبَ في مجلس اتحاد الكتاب العرب بدمشق، وكان رئيساً لفرعه بحلب، أسهم في تأسيس مسرح الشعب والمسرح القومي والنادي السينمائي بحلب، وشارك في هيئة تحرير مجلة «الحياة المسرحية» الدمشقية.
نظرة في بدايات حياته الإبداعية
يذكر الكاتب خليل صويلح عن بدايات أديبنا الكبير وليد: «مجلة الاعتصام التي أسّسها والده في عشرينيات القرن المنصرم، قادت خطواته الأولى إلى الكتابة. قرر بدوره أن ينشئ مجلة، لكن أحلامه أُجهِضَت بسبب شروط قانون المطبوعات التي لا تتيح لفتى صغير إصدار مطبوعة. لاحقاً سيكتب قصيدة ضد "مشروع إيزنهاور"، ويوجهها إلى الرئيس الأميركي. قرّر يومذاك أن يذهب إلى بيروت، لمقابلة رضوان الشهال صاحب مجلة "الثقافة الوطنية"، طالباً نشرها في المجلة، فتسلل عبر الحدود، لأنه لا يحمل بطاقة هوية. لكن الشهال نصحه بألا يقلد أسلوب أحد: "كنت أقلّد قصيدة كتبها عبد الرحمن الشرقاوي ووجهها إلى الرئيس الأميركي". تلك النصيحة علمته أن يكون مجدِّدَاً ومبتكِراً في كتاباته، ما قاده مبكراً إلى دروب التجريب، سواء في الرواية أو في المسرح. هكذا جائت روايته الأولى "شتاء البحر اليابس" (1965)، بمثابة تمرّد على السرد التقليدي في الرواية السورية».
وضعه العائلي
يذكر الكاتبان نبيل سليمان وبو علي ياسين في كتابهما «أيديولوجيا الأدب في سوريا في نهاية الستينات وبداية السبعينات» أن أديبنا وليد إخلاصي في تلك الفترة كان متزوجاً ولديه ولدان.
أزمة قلبية
يذكر الكاتب خليل صويلح: «المهندس الزراعي الذي عمل سنوات طويلة خبيراً للأقطان، يكتفي اليوم بمراجعة مسودات رواياته ومسرحياته، بعدما توقف عن الكتابة للصحافة. فالأزمة القلبية التي ألمّت به قبل سنوات، اضطرته للتوقف عن تدخين الغليون»، ويعني بقوله «منذ سنوات» بدايات سنوات الألفين.
الوظائف التي شغلها
اُنتُخِبَ في مجلس اتحاد الكتاب العرب بدمشق، وكان رئيساً لفرعه بحلب، وشارك في هيئة تحرير مجلة «الحياة المسرحية» الدمشقية. وهو عضو هيئة تحرير مجلة «الحياة المسرحية» التي تصدرها وزارة الثقافة.
عالميته
قدمت الفرق المسرحية عدداً كبيراً من أعماله الدرامية في سورية، مصر، الكويت، الإمارات العربية، لبنان، تونس، قطر، البحرين، المغرب، العراق، وليبيا. وقد تُرجِمَت نماذج من أعماله إلى أكثر من لغة عالمية منها الإنكليزية، والفرنسية، والروسية، والألمانية.
الجوائز التي نالها
1) الجائزة التقديرية لاتحاد الكتاب العرب 1989.
2) جائزة ملتقى القاهرة الأول للقصة القصيرة 1991.
3) وسام التكريم في مهرجان القاهرة المسرحي التجريبي 1992.
4) جائزة بلدية حلب 1996.
5) جائزة سلطان العويس في دورتها الخامسة للثقافة والرواية والمسرحية 1997.
6) وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة 2005.
أعماله
في القصة
1) قصص التاريخ.
2) دماء في الصبح الأغبر، مجموعة قصص، حلب، مكتبة الشهباء، 1968.
3) الطين، بيروت، منشورات عويدات، 1971.
4) الدهشة في العيون القاسية، مجموعة قصص، وزارة الثقافة، 1972.
5) التقرير، دمشق، اتحاد كتاب العرب، 1974.
6) زمن الهجرات القصيرة، قصص للثورة الفلسطينية المنتصرة، 1975.
7) موت الحلزون، دمشق، اتحاد الكتاب العرب، 1978.
8) الأعشاب السوداء.
9) يا شجرة يا..، طرابلس، ليبيا، المنشأة الشعبية، 1981.
10) خان الورد، دمشق، اتحاد الكتاب العرب، 1983.
11) ما حدث لعنترة، دمشق، وزارة الثقافة، 1993.
12) الحياة والغربة وما إليها، دمشق، وزراة الثقافة، 1998.
13) حلب بورتريه بألوان معتقة (حكايات)، دار نون، 2006.
في الرواية
1) شتاء البحر اليابس، 1965.
2) أحضان السيدة الجميلة، دمشق، دار الأجيال، 1968.
3) أحزان الرماد، بيروت، دار المسيرة، 1979.
4) الحنظل الأليف، دمشق، دار الكرمل، 1980.

5) زهرة الصندل، دمشق، دار الكرمل، 1981.
6) بيت الخلد، دمشق، اتحاد الكتاب العرب، 1982.
7) حكايات الهدهد، بيروت، مؤسسة فكر للأبحاث، 1984.
8) باب الجمر، دمشق، اتحاد الكتاب العرب، 1984.
9) دار المتعة، لندن، رياض الريس للكتب، 1991.
10) ملحمة القتل الصغرى، دمشق، دار كنعان، 1993.
11) الفتوحات، رواية عربية، دمشق، وزارة الثقافة، 2001.
12) سمعت صوتاً هاتفاً، دمشق، دار كنعان، 2003.
13) الحروف التائهة.
14) رحلة السفرجل، بيروت، رياض الريس للكتاب، 2008.
دراسات ومقالات
1) المتعة الأخيرة: اعترافات شخصية في الأدب، دمشق، دار طلاس، 1986.
2) السيف والترس: حوار عربي عن الثقافة، دمشق، دار الذاكرة، 1994.
3) لوحة المسرح الناقصة، دمشق، وزارة الثقافة، 1997.
4) في الثقافة والحداثة، دمشق، دار الفاضل، 2002.
5) من الإسكندرونة إلى الإسكندرية محطات في السيرة الذاتية، القسم الأول، 2008.
6) الوسواس الخفي، محكيات، حلب، نون للنشر.
في المسرح
1) العالم من قبل ومن بعد، مسرحيتان، دمشق، الفن الحديث العالمي، 1965.
2) الصراط، دمشق، اتحاد الكتاب العرب، 1976.
3) سهرة ديمقراطية على الخشبة: كوميديا عابسة، دمشق، اتحاد الكتاب العرب، 1979.
4) هذا النهر المجنون، بغداد، الأقلام، 1976.
5) مسرحيتان عن قتل العصافير، دمشق، اتحاد الكتاب العرب، 1981.
6) أوديب: مأساة عصرية، طرابلس، ليبيا، المنشأة الشعبية، 1981.
7) أغنيات للممثل الوحيد، أربع مسرحيات، دمشق، وزارة الثقافة، 1984.
8) أنشودة الحديقة، مأساة، طرابلس، ليبيا، المنشأة العامة، 1984.
9) من يقتل الأرملة، خمس مسرحيات، دمشق، وزارة الثقافة، 1986.
10) مسرحيتان للفرجة، دمشق، وزارة الثقافة، 1988.
11) رسالة التحقيق والتحقق، ثلاث مسرحيات، دمشق، اتحاد الكتاب العرب، 1989.
12) لعبة القدر والخطيئة، مسرحيتان، دمشق، وزارة الثقافة، 1994.
13) العشاء الأخير: مجهولان في المعادلة، مسرحيتان، دمشق، وزارة الثقافة، 2005.
14) الليلة نلعب، ثلاث مسرحيات، دمشق، الهيئة العامة السورية للكتاب، 2009.
دراسات حول أدبه
1) أطروحة ماجستير في الدراسات الأدبية للباحثة علياء الداية، بعنوان: «في التجربة المسرحية عند وليد إخلاصي».
2) رسالة الدكتوراه للباحث إدمير كورية في أميركا بعنوان: «الشكل والمبنى في مسرح وليد إخلاصي».
وليد إخلاصي والمسرح[2]
تُستخدَم كلمة الدراما والدرامي لتدل على الدراسات في مجال فن المسرح، و«الدراما» كلمة يونانية الأصل، ومعناها الحرفي هو «يفعل» أو «عمل يُقَام به»، ثم انتقلَت الكلمة من اللغة اللاتينية المتأخرة «drama» إلى معظم لغات أوروبا الحديثة. ولأن الكلمة شائعة في محيطنا المسرحي، فيمكن التعامل معها على أساس التعريب، فنقول عمل درامي، حركة درامية. وفي مجال النقد الحديث، قد تشير الكلمة إلى المسرحيات الجدية التي لا تميزها خصائص المأساة.
أ) أنواع المسرح:
لقد تغيّر المسرح وتطوّر عبر الأزمنة المتعاقبة، فتنوّعَت أشكال المسرحية، فثمة المسرحية الكلاسيكية والرومانسية والواقعية والطبيعية، وكذلك الاتجاه الرمزي والتعبيري وصولاً إلى مسرح العَبَث واللامعقول، اللذين يعكسان الحيرة والتعقيد في الحياة المعاصرة. وتظهر إلى جانب هذه الأشكال ظاهرة التجريب في المسرح، في سعيها إلى التخلّص من التقاليد. غير أن أنماط المسرحية بقيت منتظَمَة ضمن إطار الأنواع الكبرى المسيطرة: التراجيديا، التي تركز على شخصية بعينها تواجه مصيراً مؤلماً لا تملك دفعه، والكوميديا، التي تستقطِب أحداثها الاهتمام، وتسهِم مجموعة من الشخصيات في بلْوَرَة فكرتها الأساسية، وكل من الميلودراما، والمهزَلَة، والتراجيكوميديا.
إن وليد إخلاصي، يسعى إلى التجديد والابتكار والتجريب في المسرح، وينتمي إلى الجيل المعاصِر من الكتّاب المسرحيين في سورية، ففي مسرحه نجد أنه تشرّب القديم في حزمه ووضوح رسالته، ونحا إلى الجديد مستفيداً من مراحل تطور المسرح كلها، وصولاً إلى البراعَة في الابتكار وطرق أبواب التجديد، والتفاوت في تقنيات الكتابة وتنوّع أساليبها الفنية، مما يجعل محاولة تصنيف إبداعه المسرحي أمراً صعباً ومهمة شاقة قد تختلف فيها آراء النقاد أو تتشعّب.

ففي كتاب «الأدب المسرحي في سورية – نشأته وتطوره» يتركز رأي الناقِد الدكتور نديم معلاّ محمد حول وليد إخلاصي في أن أهم ما يميزه هو «غزارة إنتاجه»، وتنقّلِه بين الأجناس الأدبية المختلِفَة، من قصة ومسرحية ورواية، عبر أشكال مختلِفَة ومتباينة إلى حد كبير. ويؤكد أن ما يلفت النظر في أعمال إخلاصي المسرحية هو اعتماده على التجريب والأشكال المسرحية الجديدة، واهتمامه بقضايا الإنسان في مواجهة الواقع المحيط بما فيه من ظلم واستغلال.
إن الرمز عند إخلاصي هو «حل وسط بين الواقعية والعبث»، كما أن التجريب يتيح له تجاوز الدراما التقليدية تارة بالخروج عليها أو المحافَظَة على بعض منها داخل العمل الواحد. إنه كثيراً «ما يتمسك بالعقل والتجارب الصادرة عنه» بدلاً من العاطفة والانفعال السطحي، ويبرز ذلك في المعالَجَة العقلية الهادئة، كما في تناوله للقضية الفلسطينية على سبيل المثال.
أما الناقِد فرحان بلبل فهو يقسِّم مسرح إخلاصي إلى ثلاثة أقسام تتداخل الحدود فيما بينها:
أولاً: المرحلة الواقعية وتتركز حول الصراع في قضية فلسطين ضد العدو الصهيوني، ومعالَجَة بعض الأمور الاجتماعية والمشكلات كالجريمة في المجتمع، والانتهازية، والظلم، والفقر، والمال، وكذلك مشكلات فساد الفن والمسرح التجاري وطغيانه. إن حلول هذه المشاكل كثيراً ما تبدَّت بمظهر أخلاقي مثالي هارب من المواجهة غارِق في العموميات مما جعل «الدعوة إلى الحرية شعاراً عاماً نبيلاً وضائع الملامح».
ثانياً: مرحلة الاتجاه نحو الرمز حيث الرمز أساسي في مسرحه وقد يتكون من الأشخاص أو حتى الأشياء وقطع الديكور وأحياناً تصبح «المسرحية كلها رمزاً لفكرة». كما يتداخل الرمز واللامعقول فيلعب القدر الأعمى دوراً بارزاً عندما تنهار بسببه الأحلام التي تريد القضاء على الأمراض الاجتماعية والمآسي الإنسانية، كالشر والفساد، مما يؤدي إلى استسلام العواطِف الإنسانية كالحب والصداقة مقابل الفساد الاجتماعي والظلم.
ثالثاً: مرحلة التأثر باللامعقول وتتمثل في الجو العام للمسرحيات بإحكام الشقاء قبضته على الإنسان المنسحِق، في حركة دائرية مفرغة في المكان، فعلى الرغم من الأمل بالتخلص من العجز واليأس يلعَب التجريب دوره في إظهار «العالَم المسحوق تحت وطأة التقدم العلمي الذي يتحول إلى دمار»، فنجد الأمل والفرحة أحياناً، واستمرار المخاوف أحياناً أخرى.
أما إدمير كورية، فيشير في رسالة الدكتوراه التي أعدّها عن مسرح وليد إخلاصي إلى أن مسرحياته تتميز بتنوع التعابير والأدوات الفنية من خلال الشخصيات المتعددة في اهتماماتها وصفاتها النفسية وآمالها. وهذا كله يعكس الواقع المحيط بأبعاده في مزج متقَنٍ بين الأشكال الدرامية المحلية والغربية بما يشكل تفاعلاً كبيراً بين كل من الدراما الغربية والمسرح العربي الحديث. «لقد بات المسرح ساحة لتجريب البحث عن الذات»، «المسرح فن شعبي يهدف إلى الوصول باللعبة إلى قمة التعبير عن أهداف البشر والمجتمعات»، «المسرح شكل من أشكال الحداثة، وظاهرة تدل على تفاعل الرغبة بالتجديد داخل البنية الثقافية المعاصِرَة»، «الفن لقاح ضد الموت»، «الواقع كرة ذات سطوح متكسّرَة تمنح وجه الكرة تعددية مرهونة بعدد تلك السطوح التي يراها كل كاتب على هواه»، «المرأة تُعتبَر مقياساً صادِقاً لأحوال المجتمع». من خلال العبارات السابقة التي تلقي بعضاً من الضوء على وليد إخلاصي في نظرته إلى الحياة والإبداع والمسرح، نجد آراءه تتمحور حول أن التجريب يتضمن الاجتهاد والابتعاد عن التقليد، إنه أشبه بالعمل الذي له طابِع العلم، يستخدم العقل من أجل الخروج على القاعدة والمألوف، ويعتمد على تفاعل الأدوات المسرحية للوصول إلى الجوهر الدرامي الأصيل للنص. يدعو إخلاصي إلى أن يصبح المسرح العربي طقساً يعتاده الناس، لا مجرد تظاهرة طارئة بين حين وآخر، فالمسرح مدعو إلى القيام بوظيفته في التوصيل الكامل للأفكار، من خلال جانبيّ النص المسرحي بما فيه من قواعد تستوعِب التحولات التاريخية في مسيرة البشرية، والعرض المسرحي الذي يكوّن المتعة الروحية والعقلية ويخلق الروابط مع الجمهور. ولابد للمسرح من ركائز أساسية أهمها المثاقفة مع المسرح العالمي متضافرة مع قواعد أربع أساسية، هي: العمل، والإتقان، والإبداع، والتوصيل. بما يعطي الفرصة للتعامل الدقيق مع الاحتفالية المحلية في تجلٍّ للصراع والعلاقة المتغيِّرَة مع كل من المكان والزمان الذي فيه النظرة إلى مستقبل أفضل للإنسان.
الزمن سبب عند إخلاصي للقلق والحيرة والخوف، لذلك يلجأ إلى المكان، حيث يتجسّد الصراع الذي أصبح البطل المعاصِر فيه إنساناً عادياً يقاوِم ظلم الحياة بالإرادة والحب. كما أن المرأة رمز للعطاء، وحريتها قضية ملحّة على المجتمع ولها حضور قوي في مسرحياته كلها إلى جانب تركيزه على حق الإنسان في قيَم الحياة الكريمة.
يلجأ إخلاصي إلى التجريب على الرغم من اعتقاده بأنه قد يعيق معرفة المتلقين أسلوبه وهويته. ولكن، مع ذلك، فإن الرؤى الناظِمَة لمجمل التجربة المسرحية لدى وليد إخلاصي تعبِّر عن النمط الدرامي لديه، الذي أضحى بتنوّعه متجانساً في تنقّله بين الأدوات الفنية المختلفة المنسجمة جميعها في إطار من فهم الواقع بما يترك جزءاً كبيراً من مساحة النص للمتلقي قارئاً ومشاهداً.
ب) الرموز الأسطورية في مسرح وليد إخلاصي:
إن الرموز المدروسة مرتبطة في مسرحيات إخلاصي بمحدودية المكان، ولكنها تتنوع، فبعضها مكانيّ بحت، كالكهف وتفرعاته في فصل «المعذّب» والآخر نباتي ثابت مكانياً كالحديقة في فصل «الجميل»، والشجرة في ملحق «الجليل»، والغابة في فصل «القبيح»، في حين أن الرمزين المتحركين اللذين ينتميان إلى فئة الحيوانات هما الطائر في فصل «الجميل» والأفعى في فصل «القبيح».

ومع التتبع المتسلسِل لورود هذه الرموز في البحث، نجد الطائر مرتبطاً بالحياة من جهة تحقيقه المثل الأعلى لدى الشخصيات في الحياة والتغلب على نُذُر الموت ومؤشراته، حيث الشخصية داخل المسرحية تواجه حرباً إما خارجية ضد مجموعة من الخصوم، أو داخلية مع صراعات النفس وتضارب رغباتها وأهدافها في الحياة، وذلك من خلال اختلاف الرمز إلى الطائر بين كونه كائناً حياً، وكونه آلة مصنوعة هي الطائرة التي تهوي ومعها أحلام الشخصيات وطموحاتها. كما أن ارتباط الطائر، من جهة أخرى، بقيمة الحرية، عن طريق الطيران الذي لا يحدّه حاجز، يجعله حلماً يراود شخصيات المسرحيات، ويثير تساؤلاتها حول تفسير قيمة الحرية، ومدى تحققها على أرض الواقع. أما القيمة الجميلة الثالثة ذات العلاقة بالطيور فهي الحب الذي تثور حوله صراعات كثيرة في المسرحيات، ويتداخل مع قيمة الحرية في بيان موقع الشخصية المحبّة من المجتمع حولها.
تظهر الحديقة أشبه بعالَمٍ سحري، فالشخصيات يسكن خيالَها تصوّر الجنّة حيث النعيم الأبدي، وهي في الوقت ذاته، مَثَل أعلى في الجمال، تحاول الشخصيات المسرحية إيجاده في الواقع، فتارةً تتمثله في الماضي حيث التخفف من مسؤوليات الحاضر، وتارة تصارع التناقضات المتمحوِرَة حول مشكلة الفقر وضرورة الحصول على المال، وما يستتبع ذلك من أسئلة حول قيمة السعادة في حياة الإنسان. كما يكون اختلاف وجهات النظر حول الحياة بين كل من الرجل والمرأة، والشباب والكهول، سبباً في زيادة المعاناة من هموم الحياة، ويبدو التطلّع إلى حياة خالية من المتاعِب ضرباً من الخيال. وفي مسرحيتين لإخلاصي يظهر أن الحديقة التي تُطرَد منها إحدى الشخصيات، هي الجنة نفسها التي تستعد لاستقبال شخصيات جديدة في مسرحية أخرى، ولكنها تبقى عالَماً تكمن الجدوى منه في المسافة الفاصِلَة بين الطرد والدخول، أي في الحياة نفسها، فهي القيمة الجميلة لا الحديقة بحد ذاتها.
تندرج الشجرة ضمن مكوّنات الحديقة نظرياً، لكنها تحمل خاصية الجلال في الوعي الجماعي الإنساني، فهي مركز العالَم الذي يوحي بالسيطرة، ومن هذا المنطلَق تكون مصدراً للقوة، مرتبطة بمفاهيم الإنسان الخاصّة بالعائلة التي تشبه الشجرة، أو هي شجرة فعلاً بترابطها ونشوئها من مصدر واحد، وكذلك بالمفاهيم الخاصة حول أشجار معمِّرَة لها سطوة بكونها تشهد زمناً متطاوِلاً، كما هي شجرة الزيتون، أو أشجار ضخمة تفرش ظلها على مساحة كبيرة كشجرة السنديان القوية. وهي تعطي إحساساً للشخصيات (منشؤه اللاوعي الجمعي) بالقوة والتصميم على مواجَهَة مصاعبِ الحياة كالحروب، أو الخلافات مع الآخرين، من منطلق ظلم الحياة وغياب العدالة فيها. وهذا ما يتجلى أيضاً عند استعراض الشجرة بوصفها محوراً للزمن، حيث تكون الشجرة محوراً للمسرحية التي تضع شخصياتها أمام خيارات طريقة التعامل مع الحياة انهزاماً أو تحدياً.
مثال: مسر حية «نادي المتعة 21» (1965):
نجد القادِم الذي يُنذِر أعضاء النادي باقتراب الكارثة ويشكو حزنه العميق وألمه لفراق محبوبته بسبب حلول الكارثة وانتشار الموت الذي خطف الحبيبة منه تحت شجرة الجوز. إن اللقاء عند الشجرة لم يثمِر الحياة وإنما اختطف أحد الطرفين في توكيد لسطوة الموت، وطرح إمكانية الهرب من أجل الحياة عند الطرف الآخر، وحتى يُحذر الآخرين من هذه المصيبة. لقد أدى تسرب جزء من أبخرة الأنابيب إلى تسمم الهواء، وبات الجميع ينشدون الهرب.

تظهر الشجرة بقوة لتشير إلى جلال الزمن وسطوة الموت على كل شيء وكأنه الخالِد الوحيد. غير أن المرأة تطلِق سراح العملاق بعيداً عن عوالِم الموت. إنها تكتشف الجانب الآخر للجلال، فللأشجار مهمة مختلفة عن مجرد احتضان الموت، وبإمكان المرء أن يكون نفسه شجرة كما قالت المرأة في أثناء حوارها مع أعضاء نادي المتعة 21 «سأواجهه هكذا، قوية، كسنديانة الغابات الوحشية».
الأفعى في عرف الأساطير نقيض للطائر، فهي تلازِم الأرض، في حين أن الطائر ينطلق في السماء، وهكذا ما عزّز تناول البحث لها باعتبار أن القبيح يتجلّى من خلالها، كما تجلّى الجميل في الطائر في الفصل الأول من البحث. والأفعى بأنواعها الثلاثة: الراهنة، والحياة المتجددة، والقاتلَة، تعيش من خلال الخروج من تجربة الموت. وهذه هي التجربة التي تصورها المسرحيات في مواقفها المتباينة، فالأفعى الحاضِرَة هي كائن حي موجود فيزيائياً يثير الرعب في الشخصيات، لكن الشخصية تتمسّك بقيَمِها الجميلة في مواجهة القبيح، بما يوضح الحد الفاصل بين هاتين القيمتين. كما أنها حين تمثل الحياة المتجددة تتقنع بنموذج من الشخصيات التي ترمز إلى الأفعى، ومن خلال تبلور مواقف الصراع بين الشخصيات الشريرة كشر الأفعى، والأخرى الطيبة، يتضح صراع الجميل والقبيح، المستنِد إلى اختلاف مفاهيم قِيَم الحياة بين الانتهازية والتمسّك بقِيَم الخير والصالِح العام. أما الأفعى القاتلة، فتصور حالة يائسة من الحياة، تظهر فيها الشخصية ضحية معذّبة لظروف الحياة، بما يرينا الجانب القبيح الأكثر قتامة في الحياة.

ما يجعل البحث يصنِّف الغابة ضمن فصل القبيح هو دورها في إحباط الشخصيات وتثبيط هممها، مما يترك أثراً في المسرحيات من منطلق أن الغابة مكان واسِع يحجب الشمس ويؤدي المسير فيه على غير هدى إلى الضياع بين الأشجار، فهي ملمَح من الحياة التي تصوّرها بعض مسرحيات وليد إخلاصي، لاسيما حين تكون الحياة أشبه بوحشية الغابة بانتشار الجرائم فيها، وضياع القيَم الجميلة. كما أن ما يُسَمّى بقانون الغابة في انتصار القوي على الضعيف، واستغلال القوة لمآرِب فيها تعدٍّ على الآخرين، وتحقيق مصلحة طرف دون آخر، يؤدي غالباً إلى تحويل الحياة إلى مكان قبيح، ينفّر من العيش فيه، فيصبح مكاناً طارداً لأسباب الحياة، جاذباً للموت الذي يحمل الدمار والفناء، وكذلك هو الاغتراب النفسي للشخصية، طريق قريب إلى الموت يمر عبر مفاهيم قسوة الغابة.
الكهف بوصفه رمزاً أسطورياً يشير إلى الولادة والانبعاث مجدداً للانطلاق برؤية جديدة إلى الحياة، يحمل قيمة إيجابية، ولكنه من حيث احتواؤه الشخصية المسرحية ضمن فترة التحول، يميل إلى قيمة المعذّب. ففي أنواع الكهف الخمسة: القبر، الملجأ، غرفة الذكريات، غرفة المنزل، والسجن، تعاني الشخصية ساكِنَة الكهف أو المكان المغلَق من العزلة عن العالم، وتمر بفترات من اليأس والقنوط من الحياة، بما يجعلها شخصية سلبية تثير مشاعر مضطرِبَة عند المتلقي، وعند باقي الشخصيات في المسرحية، تتراوَح بين النفور والتعاطف. إن المسرحيات المدروسة التي يمثل القبر محوراً مكانياً أساسياً فيها، تنتهي نهاية إيجابية بالتغلب على قيمة المعذّب، لتنبثِق منها قيمة الجميل التي تترك أثرها في المجتمع المحيط وفي المتلقين. أما الملجأ، فهو مرتبط بعمليات المطاردَة، ولكن قِيَم الخير هي التي تنتصِر في النهاية، ليقوم كل من الشخصيات بصياغة مفهومه عن الجميل. إن غرفة الذكريات تذكي الماضي الجميل في مواجهَة الحاضِر الذي خلا من مفاهيم الجمال، لذا فإن انهيار هذه الغرفة معنوياً، هو الحدَث الأبرَز الذي يقلب أدوار الأزمنة ليسائل المستقبل عن ماهيته. وعلى نحو مشابه تسير التفاصيل في غرفة المنزل، لكنها تبلور صراعاً أكبر بين مجموعات من الشخصيات التي يريد كل منها السيطرَة على الآخَر بالقوة، ويكون الانتصار في النهاية رهناً بمدى وعي الطرف المنتصِر لقِيَم الحياة وأسرار اللعب مع الزمن فيها.
مثال: مسرحية «أنشودة الحديقة»:
إن الفكرة الأساسية في المسرحية وُلِدَت في الكهف، وهو هنا كهف حقيقي، على الرغم من مشاهِد المقدمة الطويلة التي تشرح كيف وصل مختار إلى الكهف. إن الكهف هو نقطة تعرَّف مختار من خلالها على العالم الفعلي بعيداً عن العالم التخييلي حيث كان يقيم مع والده وإخوته، ومع ذلك فإن العالَم التخييلي حيث حديقة الأب الواسِعَة وقصره المنيف، يبدو هو والعالَم الفعلي حيث تشكل المنازل البسيطة والفقر والحاجة إلى العمل عالَمَيْن متقابِلَيْن يشكّلان وحدة مقابل الكهف الذي سكنه مختار.
إننا نرى مختاراً، طوال المسرحية، معذّباً نفسياً بانقسامه بين اتجاهين يحكمهما المكان: الأول هو الحديقة حيث رغبته في نيل رضا الوالد الذي يسيطر عليها، والثاني هو الحي والأراضي المحيطة التي يسعى مختار إلى نيل نصيب وافر فيها، وهو يرى نفسه مقيّداً: «كان الاختيار قاسياً جائعاً أم سارِقاً، قاتلاً أم قتيلاً». وبين الخيارين يقف الكهف الذي كان نقطة التحول في وعي مختار ذاته، هذا الوعي الذي تشكّل ببطء لكنه أسفر عن انبعاثه من جديد، فبعد أن صار قوياً، حصل على ما يريد وأصبح مكتفياً بذاته، له أملاك واسِعَة ومكانة بين أهل الحي.
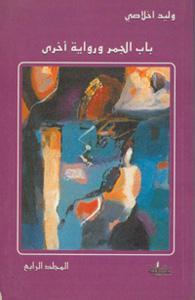
بقي في مختار – رغم ذلك – حنين إلى الحديقة حيث نشأ، وهو راغِب في العودَة إلى حيث كان كل شيء مطلقاً ومتاحاً بلا عناء، لكن الأب الذي يقبل أخيراً التحدث إليه يواجهه بالحقائق «الإنسان مسؤول عما فعل، وأنت اخترت دنياك، فابنِ حيث اخترت، لست بحاجة إلي».
لقد تسبَّبَت زوجته حياة في اقتياده إلى عالَم العذاب والمصاعِب، كما جذبَت المرأة أنكيدو في ملحمة كلكامش إلى عالَم البشَر. لقد فقدَ مختار نعيم الحديقة، كما فقد أنكيدو صحبة الحيوانات بعد لقائه المرأة، لكنه – بفضلها – وعى ضرورة استقلاله بنفسه وتحمَّل نتائج خياراته، فكان إدراكه جوهر الحياة القائم على جدلية العذاب والجمال، فالعالَم متحرك ومختار ثابت في كهفه، الحديقة ثابتة أيضاً، وهو مضطر إلى الاختيار من بينهما.
وأخيراً، تأتي آخر صورة للكهف في مسرحيات إخلاصي وهو السجن، فهو فرصة لمناقشة الشخصيات خياراتها في الحياة، وهي في هذا المكان المنعزِل موضع اتهام، وتتمكّن من مجابهة المخاطر والتصدي المنطقي لها، في الحصول على حريتها والتغلّب على عذاباتها.
قراءة في مسرحية «الليلة نلعب»
يبدو التجديد في هذه المسرحية من عدة جوانب. من ذلك أن تسعة ممثلين فقط – رجل وامرأة وسبعة وجوه – يقومون بجميع أدوار المسرحية، بحيث أن الوجه الواحد يؤدي أكثر من دور، كما تتخذ المسرحية شكل «المسرح ضمن المسرح».
يريد وليد إخلاصي أن نتعلم من تاريخ الإنسان، فانطلق من أسطورة آدم وحواء وابنهما قابيل وهابيل، فجعل بذلك تاريخ البشرية يقوم على الخطيئة والجريمة.

ويتبين من خلال عمله هذا أن الكاتب لم يتبع نظرة معينة إلى الإنسان والعالَم والتطور، فهو انتقائي: أحياناً يأخذ من الماركسية، أخرى من الوجودية، أحياناً ينظر بعين المادي، وأخرى بعين المثالي، وهناك التأثير الديني إلى جانب التأثير العلماني، الاشتراكي إلى جانب البورجوازي.
أ) الحفرة والوجوه:
إن الانطلاقة في المسرحية وجودية: فثمة رجل وامرأة يجدان نفسيهما ساقطين في «حفرة»، يبدو لهما أن الخروج منها مستحيل. يلعبان بالاشتراك مع «الوجوه» لعبة آدم وحواء، لعبة الحياة. وهكذا يمثلان تاريخ البشرية. أخيراً، يلعبان لعبة الأمل، ويكتشفان طريق الخروج من الحفرة.
الرجل: كيف سقطنا؟ لابد أن أحداً دفع بي إلى الحفرة.
المرأة: أو أنك كنت مغمض العينين، أو أنك تنظر إلى الأعلى، ولكن لِمَ نبحث عن الماضي؟
ومع ذلك يمكن مع شيء من الصعوبة التوصل إلى ما وراء الحفرة: فهي حالة طارئة تبدو اعتيادية (الرجل يتأمل المرأة وكأن سقوطها كان شيئاً عادياً) يقع فيها المرء كما في الفخ: «أيتها الواقعة في الفخ»، هي كالقبر: «أنتِ في القبر، ولكنكِ لم تموتي بعد»، الحفرة سقطة الخطيئة: «وتقع الخطيئة على العتبة، وتولد كل يوم ألف مرة»، عَثَرَة إنسان مستلَب إنسانياً: «منذ أن تعثرت ذات يوم، كنت منهكاً ضائعاً ووحيداً، مطروداً من أمن نفسي، لم أر الحفرة، كانت واسعة فلم أرها، سقطت». والاستلاب تم في نظام معين: «سقطت في الفخ وفق خطة مرسومة، والجنون أن ليست هناك خطة للخروج أبداً». والحفرة أخيراً هي الوحدة والحرمان العاطفي: «بعيدون عن الأحبة، قريبون من الموت، تلك هي الحكاية». والأزمة العاطفية: «فصل للفاشلين في حبهم».
ولكن، كيف يخرج الفرد من الحفرة أو المأزق؟ يقول الكاتب: «بالانتظار والأمل والكفاح». ولكن، لا يمكن للإنسان بمفرده أن يذهب خارجاً، لابد له من مساعدة آخرين. بهذا تتدخل الجماعة لتنفي استحالة الخروج من الحفرة وتقلب – كما يبدو – النظرة الوجودية إلى اشتراكية:
«المرأة (بضيق): ننتظر ننتظر من؟
الرجل: أحداً يخرجنا، يمد لنا يد المساعدة».
ففي النهاية نرى أن الآخرين لم يساعدوا الرجل والمرأة إلا بصورة غير مباشرة، إذ توصلا إلى طريق الخروج من الحفرة، وبدآ بالمحاولة بفضل معرفتهما بالتاريخ البشري فقط. تقول المرأة: «تاريخ الإنسان الذي حكيت عنه علمني أشياء وأشياء. يا للروعة رغم تلك المحن فهو ينهض ويستمر. نحن يجب أن ننهض ونستمر».
إذن، فإن تاريخ البشرية أعطى الاثنين الأمل، وساعدهما على تصور أداة الخروج (السكين)، وبالصدفة اكتشفا أن أظافرهما – التي استطالت خلال فترة مكوثهما في الحفرة – يمكن أن تقوم بوظيفة السكين.
فالفكرة الأساسية في المسرحية وجودية. والحفرة تعني بالنسبة للكاتب «اللااختيار» والخروج منها يعني «الحرية». فإن وليد إخلاصي يقول بلسان شخوصه: «لقد وقعنا في فخ اللااختيار»، «يجب أن نصل إلى الثقب الواسع والذي سيؤدي بنا إلى الحرية».
يربط الكاتب هنا مصير الفرد بمصير البشرية، يقول الرجل: «أريد أن أكتب للجنس البشري وأغني له. أيتها المرأة أريد أن أساهم في بناء الحضارة». ثم يعبر الرجل للمرأة عن لواعجه التي يتحدث فيها عن المحبة والسلام، محبة الآخرين والعيش معهم بسلام.

الرمز الآخر الذي ندخل منه إلى المسرحية هو «الوجوه». فماذا تمثل الوجوه؟ هي تمثل التاريخ وتعرُضُه، هي حيادية، تراقِب وتخرج بالحكم والحكمة. ومن ناحية أخرى، يمكن الذهاب إلى أنها تمثل الزمن: سبعة وجوه – سبعة أيام. ولقد جعلها الكاتب في المشهد السادس تبدو وكأنها وكيلة الله على الأرض، كأنها ملائكة الرقابة الإلهية، وعلى كل حال فهي إبداع غني.
ب) بين العلم والأسطورة:
«المرأة: الغواية.
الرجل: الشيطان وشجرة التفاح؟
المرأة: لا أعتقد أن مثل هذه الأمور كانت لازمة، فاللقاء كان طبيعياً لكي تأخذ اللعبة شكلها الطبيعي».
لقد كان الكاتب بين خيارين: خلق الله آدم وحواء إنسانين «كاملين»، ثم أغواهما الشيطان ودلَّهما على الغرائز، أو أن الإنسان خضع لقانون التطور، وههنا لا يكون للملل دور فيما يسميه الكاتب «لعبة الحياة» خصوصاً أنه جعل «الملل» دافعاً لبدء لعبة الحياة، وذكر أن آدم وحواء لم يكونا يعرفان في البدء سوى الإشارة...!!
أما أسطورة قابيل وهابيل فهي مرتبطة بالأسطورة السابقة، وهي تسعى لتأكيد نشوء الجريمة بسبب معصية الإنسان لله واكتشافه للنفس والغرائز ولجميع ملاذ الحياة وشقاواتها. إن تاريخ البشرية وفق هذا المنظور يغدو تاريخ قتل، وما علينا إلا أن نخرج من هذه الحفرة! يتساءل المرء: هل أراد الكاتب توحيد العلم بالميتافيريقا؟ التاريخ بالأسطورة؟ والمادة بالروح؟
جـ) المرأة:
تكاد تكون المرأة في هذه المسرحية معادِلاً للمطلق، فهي الماضي والمستقبل، هي كل شيء. يقول الرجل: «أحبكِ لأنكِ مستقبل كل اللحظات التي أعيشها. ولأنكِ ماضي اللحظات التي نحلم بها». «كلما وضعت رأسي في جحرك أحسست بأنك أمي وأختي وصديقتي». ولكنها مع ذلك تختلف عن الرجل منذ البداية. تقول الوجوه: «الرجال زجاج رقيق، أما النساء فصلصال مرن». وإذا تتبعنا الاختلاف نرى مثالاً على ذلك أن المرأة تقع، فلا تتأثر كالقطة؟ بينما الرجل يكاد يموت من السقطة. وما دليل أن طبع الرجال الملل أكثر من النساء؟! كما قال الكاتب على لسان الوجوه: «الرجل والمرأة وجهان لقرص، الرجل والمرأة قرص واحد».
د) سرد تطور التاريخ وصولاً إلى نظام الإقطاع والثورة ضده:
نحن الآن، في المشهد العاشر، أمام النظام الإقطاعي المتمثل في عبودية الأرض المتطورة من العبودية المباشرة، والقائم أيديولوجياً في الحق الإلهي للحاكم بعد أن كان في قمة عصر الرق الإله نفسه. ففي المجتمع الإقطاعي أصبح الإنسان المنتِج عبداً للأرض، يُبَاع ويُشرَى معها.
يحصل الفلاح في هذا المشهد على امرأته بعد صراع طويل ضد حسد الرجال، وطمع الأهل، وضرورات العيش. إنه يحبها وهي تبادله الحب. وفجأة، «تُسمَع جلبة في الخارج ثم صوت باب يُكسر، يدخل ستة رجال، يتبعهم بعد قليل، رجل هو مالِك الأرض والقرية»، كان هذا في يوم العرس:
«المالِك: وتمتلك امرأة دون علمي؟
الرجال: من يعصي أمر السيد يُضرَب. للمالك حصة.
الرجل: حصة، حصة بأي شيء؟
الرجال: للمالِك حصة لأنه سيد. للمالِك الحق في الأشياء والناس لأنه يملك. من يملك يأخذ. من يحكم يأخذ».
ويقول رجل ثالث بالنيابة عن المالِك: «لي حق أعطانيه الله»، ويوجه الرجال كلامهم إلى المالِك: «وبمائك يصبح رحم المرأة أخصَب».
سبب الصراع إذن هو رغبة المالِك في مضاجعة المرأة قبل زوجها.
وعندما يصرخ الرجل: «يا إلهي. يا إلهي إلى متى نظل عبيد الأرض وصاحب الأرض»، فليس لسبب آخر، حسب المسرحية، سوى أن ينتهي استبداد الإقطاعي الذي يسمح له باغتصاب زوجات الآخَرين.
هـ) تطور التاريخ وصولاً إلى الرأسمالية والفاشية:
في المشهد الثالث عشر يربط الكاتب بشكل جلي بين الفاشية والرأسمال، مما يدل على فهم صحيح لطبيعة الفاشية. فالزعيم الفاشي يمثل الرأسمال في مرحلة أزمة الرأسمالية المتفاقِمَة:
«رجل1: مصانع صلبي رهن الإشارة.
رجل2: وأنا أعطي أموال البنك. دون فوائد، دون إعادة.
الرجال: عاشت أموال البنك دون فوائد. المال توفر، عاش المال المتوفر.
رجل3: أسواق العالَم رهن الإصبع. والإصبع لك، أسواق العالَم لك. حرك أسواق العالَم.
الرجال: أسواق العالَم باتت لك. عاشت أسواق العالَم تخدم.
رجل4: وأنا أعطي الأوراق المطلوبة، أعطي أقلام الكتّاب. أضمن تأليف الأنباء، جميع الأنباء».
ههنا تتجلى حقيقة سيطرة الرأسمالية على الصحافة والفكر، الأمر الذي يناقِض «حرية الكلمة» التي يتبجّح بها دعاة النظام الرأسمالي. وللمرة الأولى نرى المثقفين – لدى وليد إخلاصي – يعملون في سبيل السلطة، بينما كانوا سابقاً مناوئين لها، مضحّين في سبيل الآخَرين. أما الجماهير، فهي كالسابق، مع الرجل القوي، مع السلطة. إلا أن الكاتب يستثني ثلاثة أفراد منها: الرجل وهو عامل متعطل، الشحاذ الذي كان فلاحاً، والمرأة التي انتزعوا منها زوجها وزجّوه في الحرب. الرجل نفسه، أي العامل المتعطل، يلعب دور المثقف، هنا يقول الكاتب على لسان رجل: «قديماً كنا نغني عندما لا نجد عملاً بين أيدينا، الآن لا أجد عملاً ولا أستطيع الغناء». ثم: «يا أولاد الكلبة. يا من تفبركون الجوع، وكأنه صناعة متقنة».
وينهي الكاتب هذا المشهد بانفجار ذري ودمار شامل للفاشيين ولسواهم. وهي نهاية سوداء مخيبة. أما في الواقع، فقد انتهت الفاشية، ومات عشرات الملايين وكان دمار فظيع.
و) بعد الحرب:
الرجل هنا يختلف عنه في المشهد السابق، بكونه الآن أقل تصميماً وأكثر تردداً. إنه يتبع الطريق الأسهل: «يبدو أني قد أصبحت عصبي المزاج، ويجب ألا يعلو صوتي (لنفسه) ما لك والمشاكل، عد إلى عملك فالوقت له قيمة، (لنفسه) ما لك والاعتراض، اصمت فهذا أفضل للصحة».
ينقلنا الكاتب بعد ذلك إلى «دولة الرفاهية» كما ودّ دعاة الرأسمالية تسمية دولتهم، إنه ينقلنا إلى عصر الكومبيوتر، وههنا ينتهي العرض التاريخي، لقد أنجز الكاتب حتى الآن مغامرة منهِكَة وخطيرة. فليس من السهل تجسيد مراحل التطور التاريخي المديدة والمتباينة في عمل مسرحي، فهذا يحتاج إلى فكر علمي متين وإلى اطلاع عميق وواسع في التاريخ وفي الكثير من العلوم، وإلى نَفَس طويل.

يبدأ هذا المشهد بمنظرين متعاقبين على الحائط لفترة طويلة: منجزات علمية متفوقة، منظر بدائي معاصر. إن أكثر عالمنا اليوم يعاني حقاً من هذه الازدواجية الغريبة، والتي ترتبط بوجود نظام رأسمالي إمبريالي قوي في العالَم. السمة الأخرى لهذا النظام، كما تقدمه المسرحية، هو أنه نظام مجتمع لا عقلاني بشكل مخيف، بقدر ما هو عقلاني بشكل مخيف. فهناك إنتاج فائض (الوجه الإيجابي)، ولكن السلع لا معنى لها (الوجه السلبي)، هناك صناعة متقدمة (الوجه الإيجابي)، وأكثر تقدماً هي صناعة الأسلحة (الوجه السلبي). ويصرخ وليد إخلاصي:
«صوت2: جيفارا.. يا جيفارا.
صوت1: تسقط آلات الحرب».
لقد أصبح جيفارا رمزاً للثورة ضد لا عقلانية المجتمع «السوبر عقلاني». إن خيرات العالَم تكفي البشرية وتزيد، ومع ذلك فهناك جائعون. يستطيع التقدم العلمي والتقني جعل العالَم أجمع سعيداً. ومع ذلك فهناك حروب لم يعرفها العالَم من قبل. ثم ينتقل الكاتب بنا إلى تبيان مفارقة أخرى: العلم من جهة، والتجهيل من جهة أخرى. لقد أمسى العلم يُسَخَّر في المجتمع الرأسمالي في سبيل «الجهل»: لتغطية الحقائق التي تدين النظام، لترويج بضاعة كاسدة، لكسب الناس في سبيل مصالِح خاصة ضد مصالح المجموع.
«رجل5: كنا نتصور أن الكومبيوتر لخير الناس.
رجل1: كنا نحلم أن العلم لخير الناس.
رجل2: العلم لخير الناس، لا للحرب والتزييف.
المرأة: تعالوا نستخدم هذا الكومبيوتر كما نريد، لنصنع كمبيوتراً يخدمنا.
رجل4: من نحن لنصنع! نعمل كالآلات، نُكبَس كالأزرار، نعطي».
إن المسحوقين يهمّون – بمبادرة المرأة – باستخدام العلم لصالحهم. ولكن الكاتب غير متفائل بذلك.
و) الخاتمة:
في نهاية المسرحية نعود إلى ما كنا عليه في البداية. تدعو المرأة الرجل إلى الانتحار، فيستنكِر الرجل، وبصورة عامة، فإن النتيجة التي يصِل إليها الكاتب، هي إيجاد ثغرة للخروج من الحفرة!!
قراءة في رواية «رحلة السفرجل» [4]

قسّم أحد النقاد رواية الكاتب السوري وليد إخلاصي إلى زمنين: زمن واقعي – فعلي، وآخر رمزي. واعتبر أن زمن الحكاية الفعلي يمتد على مدى ثلاثة أيام، باستيقاظ المهندس عبد المعين السفرجل الذي يعيش وحيداً في منزله، وتنتهي بركوبه القطار المسافر إلى دمشق. وما بين استيقاظه ومغادرته يلتقي برفاق المقهى المتقاعدين: العميد سامي، والوزير السابق نصر الله، وأستاذ الجغرافيا كامل السيّاف، ثم بابنته صفيّة التي يُعْلِمها بسفره. لكن هذا الزمن القصير يُخترَق باسترجاعات زمنية بعيدة وقريبة تغطّي فترة طفولته، ودراسته الثانوية، والجامعية، وأحداث الثمانينيات، وعمله بعد التخرج، ومشاريعه الهندسية، وأحلامه، وقصة حبه لثريّا، وخطبته لفاطمة وزواجه، ثم حياته الأسرية مع بناته. ويعتبر الناقد أن ما بين اللحظة الراهنة التي يعيشها السفرجل والماضي البعيد والقريب، تتوالى الأحداث المسترجعة والمعيشة، في نسق زمني متقطّع عبر التداعي والتذكّر والمونولوج والديالوج؛ لتضيء العالَم الداخلي للسفرجل، وشبكة علاقاته الخارجية التي تربطه بالوسط المحيط.
وقد استدعى هذا الانتقال الزمني البندولي ما بين الحاضر والماضي، الانتقال المكاني أيضاً ما بين حلب والحسكة، حيث تعيش ابنته عائشة، والقطار المتجّه إلى دمشق، وداخل أحياء ومعالِم حلب ذاتها، مثل: القلعة، والجديدة، وساحة سعد الله، ومحطة القطار، وساحة جامع الأطروش، والمقهى. ويتناغم الزمان والمكان في دلالتهما الواقعية والنفسية والرمزية، فيبدو الزمن الراهن (الشيخوخة والتقاعد) وفضاؤه المكاني: المقهى، والقطار، مشحوناً بالخوف والتأمل، والأسئلة الوجودية عن الموت والحياة. فيما يبدو الزمن الماضي (الشباب والدراسة والحب) وفضاؤه المكاني: القلعة، حتى الجديّدة، الحديقة العامة، مشحوناً بالحنين ورهناً للذكريات الحميمة والأحلام والمشاريع والطموحات.
وحسب مصدر آخر، فإن الفكرة الأساسية التي بُنيَ عليها العمل تقول عدة أمور، من أهمها أن تقاعد المرء بعد أن يمضي قسماً كبيراً من عمره في العمل، يشبه نوعاً من الموت. إن ما يودّع به من إشادة ومدح هو أقرب إلى رثاء لطيف لعمر لا يلبث أن يلفه النسيان.
بدأ إخلاصي بوصف أول يوم من تقاعده وتوقفه عن العمل وتوقف ساعة المنبه، وهي هنا آلة تسجيل لموسيقى كانت توقظه. نقرأ الصفحة الأولى: «كانت الدقائق التي مرت على معين السفرجل، في بدايات استيقاظه المتقلبة مدخلاً لإدراكه أن شيئاً ما يحدث في الدار، شيئاً لم يحدث مثله من قبل. واستطاع بعد قليل أن يحدد مصدر الاضطراب. فالذي حدث هو ما في الجهاز القائم في غرفة المعيشة. وكانت المجموعة التي تضم المسجل قد برمجت لتنطلق الموسيقى في الساعة السابعة من صباح كل يوم إيذاناً باستقبال نهار جديد. وبذا أصبح المسجل جهاز توقيت منتظم اعتمدت عليه ساعة الانطلاق إلى العمل، وظلت كذلك بعد أن بات متقاعداً، فلم يتغير نظام استيقاظه».
نهار طويل وهو وحيد في البيت. زوجته توجهت في زيارة لإحدى بناتهما التي تعيش مع عائلتها في مدينة بعيدة. جميع بناته تزوجن وابتعدن. درَج الآن على التوجه إلى إحدى المقاهي، ليلتقي عدداً من الأصدقاء المتقاعدين مثله.
وبعيداً عن تلخيص المصدر المذكور للرواية، نلاحظ الحجم الكبير لحضور التفاصيل اليومية في الرواية. لقد بدا الأمر أن إخلاصي لا يكتب رواية، بل يحكي قصة واقعية عن أولئك الذين يعانون كثيراً في بلادنا جراء نظام التقاعد الوظيفي. في ظل عدم وجود أي نظام لرعاية الشيخوخة. ثمة من يتساءل عن المعنى الإبداعي لهكذا نوع من الكتابة التي لا تضيف شيئاً، بل تعيد وصف الواقع الذي يعرفه ويعيشه الجميع أصلاً. فأين الإبداع؟!
يتابع كاتب المقال: كان السفرجل قد تخرج مهندساً مميزاً متفوقاً، لكنه لم يستطع أن يحقق أحلامه ومشاريعه المعمارية، فاضطر إلى قبول وظيفة في إحدى الوزارات، حيث كان رؤساؤه من الإمّعات الذين لم يكونوا مساوين له موهبةً وإنجازاً.
ويرى أن نهاية الرواية جاءت بعد أن قصد السفرجل العاصمة دمشق من مدينته حلب، ليقدم اقتراحاً إلى الوزير. فواجه إخفاقاً. في طريق العودة أصيب القطار بعطل استمر مدة طويلة. خرج السفرجل يتمشى وابتعد عن القطار المتوقف. جلس على مرتفع. يعتبر الكاتب أن ذلك يُعتبَر عودة رومانسية إلى الطبيعة. بدا له أن هناك صوتاً يناديه «اقترب يا سفرجل، فاقترب. سمعه دون أن يتحرك، من أين يأتي النداء؟ أيمين التل ينادي أم يساره؟ فخُيِّلَ إليه أن جميع الأرجاء تهتف باسمه، تدعوه. سمع فجأة صوت القطار، فانشدّ إليه يشهد عن بعد عدداً من الركاب يتسابقون في الصعود إليه».
ومر القطار، وهو لا يزال يستمع إلى النداء: «اقترب – وكان النداء كصفير قطار يخترق الروح التي كانت ترتعش في محاولة جاهدة لتلبية أمر الاقتراب»، وعلى هذا المنوال يتابع إخلاصي روايته الواقعية إلى درجة مريبة!
في حوار مع الكاتب، اعتبر إخلاصي أن «رحلة السفرجل لم تكن غريبة عن واقع الحياة. اليأس المتراكم عبر سنوات الشباب والشيخوخة للذين يمتلكون بذور الموهبة أو ثمارها، هو الذي يشكل لعنة قد ترافقهم حتى نهاية العمر. وتلك هي الضريبة يدفعها هذا النوع من البشر في مجتمعنا، وقد يدفعها في مجتمعات أخرى. وللعدل فإن هذه الضريبة سينجو من دفعها قلة من أعداد الموهوبين. هم يحلمون برؤية جديدة للحياة، وهم يشكلون طليعة خفية في مجتمعهم. ويرى إخلاصي أن المشكلة تكمن في المدن. المدينة فخ يقع فيه من يخرج عن السرب، ومن كان يمتلك موهبة ما. لأنه من المألوف ألا ينجو صاحب الموهبة، باستثناء من يمتلك القدرة على المثابرة. والمدينة فخ لما فيها من صراعات وقيود تحدّ من طاقة الإنسان. وتلك هي مدن عربية قد استشرى فيها فساد الأرواح وسوقية التفكير، ونزاع المصالِح في قتال التنافس، وأيضاً في لعبة الحصول على الكراسي».
وبعيداً عن مضمون «رحلة السفرجل»، كما يرى إخلاصي، فإن أسلوب الحكاية لم يحتمل قول ما يمكن أن يقال. فلا الإنشاء من وصف ومحسّنات يحتملها معين السفرجل لإغناء وجوده، ولا هو كبطل حكائي على استعداد لتجميل أو إضفاء الزيادات على شخصه، فهو المستسلم بعد يأس. وتلك هي الحكاية.
ويعترف وليد إخلاصي أن ما كتبه ليس رواية، ولا يحقق شروط الرواية. بل هي حكاية، إذ يقول: «رحلة السفرجل ليست سوى حكاية لم تتحقق فيها صفات الرواية، ولذا حافظت على احترامها للكيان وهو جنس أدبي نعترف به».
المراجع
1) من الإسكندرونة إلى الإسكندرية، محطات في السيرة الذاتية. القسم الأول. تأليف: وليد إخلاصي. قدم له: د.عبد النبي اصطيف.
2) أطروحة الماجستير للباحثة علياء الداية، بعنوان «في التجربة المسرحية عند وليد إخلاصي».
3) أيديولوجيا الأدب في سورية. تأليف: بو علي ياسين ونبيل سليمان.
4) مواقع الكترونية.
هوامش
[1] معظمها مأخوذ من كتابه «محطات في السيرة الذاتية»، القسم الأول، بعنوان «من الاسكندرونة إلى الاسكندرية»، تأليف: وليد إخلاصي.
[2] هذه الدراسة هي ملخص لما أتى في أطروحة الماجستير للباحثة علياء الداية من المقدمة والخاتمة ومن بعض المسرحيات التي استشهدت بها الباحثة في عملها الجميل والغني.
[3] هذه الدراسة عبارة عن ملخص لما جاء حول هذه المسرحية في كتاب «أيديولوجيا الأدب في سورية للكاتبين بو علي ياسين ونبيل سليمان».
[4] أخِذَت هذه الدراسة عن أحد المواقع الإلكترونية، ولم يَذكَر فيها اسم الكاتب.
نبيل سلامة
اكتشف سورية

